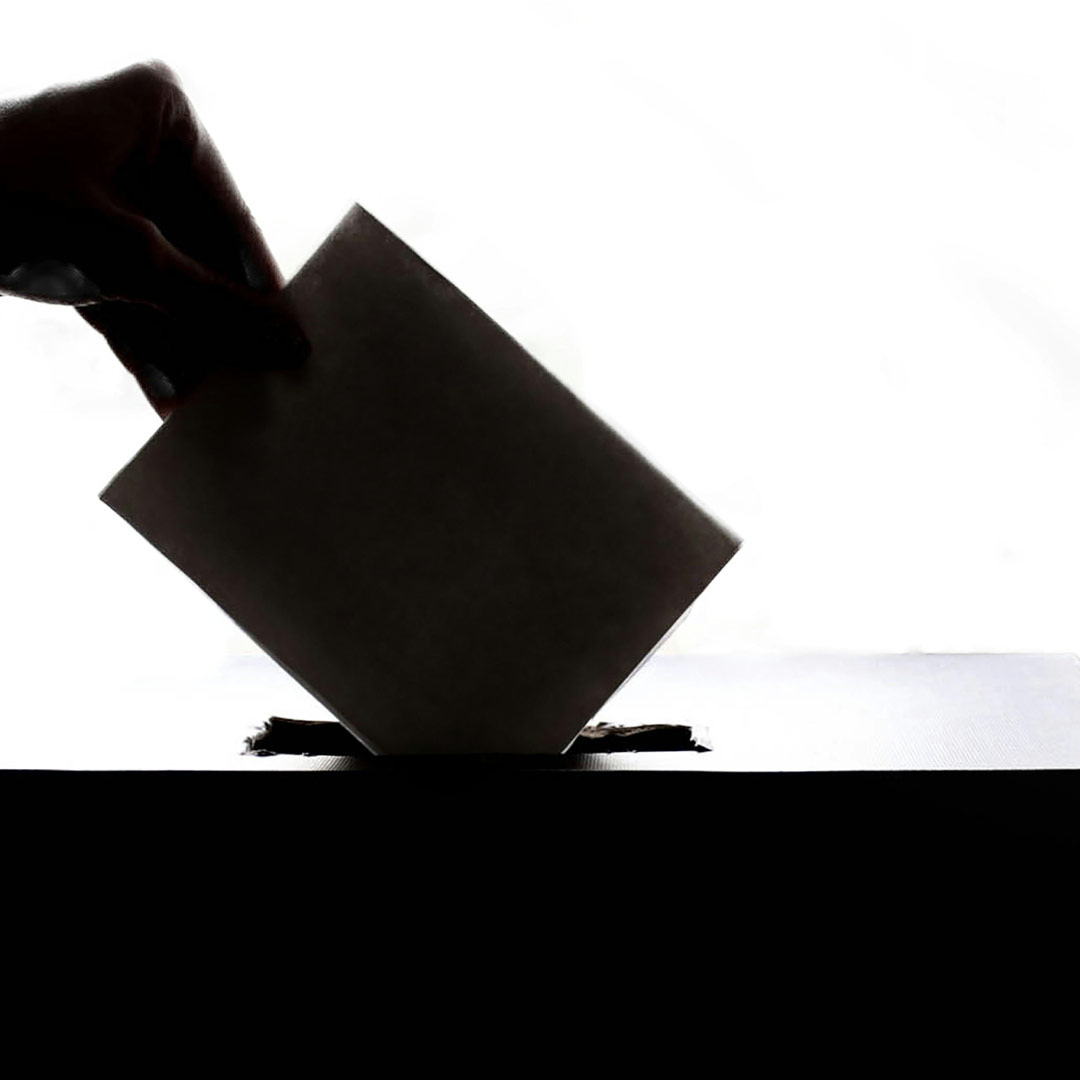بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد؛
ففي تسجيل مرئي منشور على شبكة الانترنت يظهر القرضاوي أحد أكبر دعاة الفتنة ويفتي الناس بجواز أخذ الرشوة الانتخابية والتظاهر ببيع الصوت إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، وحتى لو حلَّفه الراشي أنه سينتخب فلانًا مقابل هذا المال، فيأخذ المال ويحلف، ثم ينتخب من يراه الأحق بصوته أو المرشح الصالح، وهذا القَسَم لا يجب الإبرار به لأنه قسم على معصية!
وإذا أبرَّ بقسمه وانتخب من حلف أنه سينتخبه، ففي هذه الحالة عليه إثمين، إثم أخذ المال، وإثم إعطاء الصوت للمرشح الفاسد!
وقد مهَّد القرضاوي لهذه الفتوى بالإيضاح والتبيين والكشف عن ماهية الشخص الصالح والشخص الفاسد، وملخص كلامه أن الشخص الفاسد وهو من يقدم الرشوة الانتخابية لشراء الأصوات هو المقابل والمنافس لمرشح جماعة الإخوان الإرهابية!
والذي زكاه ووصفه بالصلاح والورع والتقوى!
كما أن الفتوى كانت موجهة لجميع المصريين من كافة التيارات السياسية والمعتقدات الدينية([1])!
تحليل الفتوى:
أولًا: الجانب الفكري:
قضى القرضاوي جزء المقطع المرئي الأول والذي زادت مدته على النصف يمهد لفتواه، فكان مما قال: «هذه شهادة، والشهادة في الإسلام يجب أن تكون لله، ﴿ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [الطلاق: 2]، لا للدنيا ولا لمال ولا لأي غرض آخر، ولذلك الإنسان عليه أن ينتخب الإنسان العادل، ﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [الطلاق: 2] ... ﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [البقرة: 283]، فلا يجوز التخلف عن الانتخابات، قال تعالى: ﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [البقرة: 282]... ولذلك أنا أقول على الإنسان أن يشهد بمن يعرف أنه إنسان خَيِّر، وأنه إنسان مقيم للحق، واقف ضد الباطل، يقيم العدل ويرفض الظلم، هذا هو المطلوب من كل إنسان، ولا يشهد زورًا أبدًا، ولذلك أنا أقول على كل مصري يخشى الله عز وجل، إنسان حريص على دينه على إرضاء ربه أن يؤدي هذه الشهادة بحقها، ويودِّها لله عز وجل ويختار الإنسان الصالح...».
ثم أخذ في الطعن في المرشح المقابل لمرشح الجماعة الإرهابية، وكيف أنه رمز للشر والباطل والظلم، وأنه لا يجوز لإنسان سواء كان مسلمًا أو مسيحيًّا، ليبراليًّا أو إسلاميًّا، رجلًا أو امرأة، شابًّا أو شيخًا أن ينتخب هذا المرشح إطلاقًا!
ثم ذكر أن الفاسدين يشترون الأصوات بالمال، وهذه المعركة لا يجب أن يدخل فيها المال، بل يجب أن تكون لله، ثم أجاز أخذ المال عند الحاجة مع وجوب اختيار الأصلح حتى لو حلف على اختيار غيره.
وبالتأمل فيما مر في محاولة لتحليله إلى عناصر أوَّلية بسيطة تمثل الأركان والدعائم الرئيسية التي بُنِي عليها منطق الفتوى، نجدها هي ذات المكونات الثابتة الأساسية في كل فتوى من فتاوى التطرف والإرهاب، وهي نفس الأركان والدعائم التي بني عليها الفكر المتطرف ككل، وذلك مثل: استغلال الدين والتجارة به لتحقيق المآرب الشخصية، الاستعلاء بالإيمان، ازدراء وتفسيق الآخر أو حتى تكفيره في كثير من الأحوال، مبدأ التقية والنفاق، الإيغال في تقسيم المجتمع وبث روح الفرقة بين طوائفه، إلى غير ذلك من أفكار هدَّامة عانت منها المجتماعات الإسلامية بل والإنسانية ككل على مدار عشرات السنوات الماضية.
وحتى يتضح المعنى أكثر، سنعرض فيما يلي تلك العناصر متبوعة بالشرح وبما يمثلها في مكونات الفتوى.
1- استغلال الدين لتحقيق المآرب الشخصية.
من المعلوم مكانة ومنزلة كل دين في نفوس أتباعه ومعتنقيه، لا سيما في مجتماعاتنا العربية، ولذلك سيكون من أقصر الطرق للسيطرة على قلوب وعقول الناس، وإجبارهم بصورة غير مباشرة على فعل ما، هو إيهامهم أن ذلك الفعل فيه مرضاة الله عز وجل، وفيه خدمة للدين وللإسلام، والنفوس بطبيعتها تميل إلى طاعة الله عز وجل، وإن تفاوت الناس في تحقيق ذلك.
وهذا بالضبط ما فعله القرضاوي في تلك الفتوى، حيث مهد واستدل بآيات قرآنية ودلل بها على وجوب المشاركة في الانتخابات، لكن في حقيقة الأمر هو استخدمها لخدمة أهداف الجماعة، حيث عطف على ذلك مباشرة بشكل واضح وجوب اختيار مرشح جماعته، وعدم جواز اختيار المرشح المنافس، إضافة إلى أنه ما إن تغيرت أهداف جماعته بتغير الأحوال، سارع بفتوى مناقضة تمامًا لهذه الفتوى، فأفتى بحرمة المشاركة في الانتخابات([2])!
2- الاستعلاء بالإيمان.
بغض النظر عن مفهوم الاستعلاء بالإيمان النظري الذي نص عليه سيد قطب في كتاباته، لكن التطبيق العملي للجماعات المتطرفة جاء تطبيقًا صريحًا لصفة الكبر المذمومة في كل الشرائع السماوية، والتي ذكرت في القرآن الكريم على أنها السبب الأبرز في ضلال الشيطان بعدما كان من العباد المقربين، لكن صفة التكبر عند جماعة الإخوان الإرهابية جاءت بصبغة دينية، فهم لا يتكبرون على الناس ولا يعتقدون الخيرية في أنفسهم عن الخلق بالجاه والسلطان أو المال والنفوذ، لكنهم يتكبرون ويستعلون عليهم بالإيمان، ونعني بالإيمان هنا ليس حتى أعمال الدين كالصلاة والزكاة والصوم وقيام الليل، ولكن غُرِس في نفوس الأتباع بشكل مباشر أو غير مباشر أن مجرد الانتساب للجماعة يكسب المنتسِب مزية فريدة، وخصيصة تكسبة قربًا من الله عز وجل، لا ينالها أي مؤمن آخر مهما صام وقام ومهما قرأ القرآن وأطعم الطعام.
هذا الفهم وهذه العقيدة الفاسدة امتزجت بأفكار المتطرفين غاية الامتزاج، حتى صار يرثها من يدافع عن قضايا المتطرفين، ويؤمن بأفكارهم ولو لم ينتسب إليهم رسميًّا، وما أكثرهم في زماننا!
وهذا الأمر يظهر جليًّا في هذه الفتوى، فإننا نفهم جيدًّا أن كل مرشح من المرشحين يكون له حزب يدعمه ويزكيه ويرى أنه الأفضل، ولكن أن يرى أنه هو الممثل للدين وللإسلام ورمزًا للخير والصلاح والتقوى، لمجرد أنه مرشح الجماعة، وأنه من المحافظين على صلاة الفجر مثلًا، فهذا بالإضافة إلى أنه متاجرة بالدين هو استعلاء بالإيمان أيضًا، ولأن معنى الاستعلاء والتكبر لا يظهر تمامًا إلا بوجود مُستعلٍ ومُتكبَّر عليه كان لابد من ازدراء الطرف الآخر وغمطه.
3- ازدراء الآخر وتفسيقه.
يقول المتنبي:
مَن يَظلِمُ اللُؤَماءَ في تَكليفِهِم
أَن يُصبِحوا وَهُمُ لَهُ أَكفاءُ
وَنَذيمُهُم وَبِهِم عَرَفنا فَضلَهُ
وَبِضِدِّها تَتَبَيَّنُ الأَشياءُ
لا يعتقد المتطرفون أنهم أقرب إلى الله من غيرهم من المسلمين وحسب، بل يعتقدون الدونية في غيرهم أيضًا، والحقيقة أن هذا الاعتقاد يأتي مكملًا لما سبقه من اعتقاد الخيرية الزائفة في النفس.
وعلى اختلاف دركات التطرف، فكلما أوغل صاحب التطرف فيه، كلما فسد اعتقاده في الآخر، فمن مجرد النظرة الدونية إلى التكفير ووجوب إهدار الدم!
وهذا ظاهر وواضح في تلك الفتوى أيضًا، فقد حرص القرضاوي أيما حرص على النيل من المرشح المقابل لجماعته، ووصفه بأنه رمز للفساد ورمز للشر والباطل، بالرغم أنه مرشح بالفعل إلى الانتخابات وفي مرحلتها النهائية، مما يعني أنه وطبقًا للقانون ليس محكومًا عليه في جريمة أو جناية واحدة ولو رد إليه اعتباره.
ولكن العيب الحقيقي والوحيد الذي لم يجهر المفتي المتطرف به أن المرشح ليس منتسبًا لجماعة الإخوان الإرهابية وليس مؤمنًا بأفكارها بل هو مناهض لها.
4- مبدأ التَّقِيَّة والنفاق والكذب.
القصة الواضحة التى تُظهر عقيدة التقية لدى الإخوان تبدأ بعبارة شهيرة قالها البنا هى: «ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين»، ولهذه العبارة قصة، وهى قصة مرتبطة باغتيالات وتخريب وحرق وقتل، كان الإخوان قد قتلوا أحد المستشارين من رؤساء محاكم الجنايات اسمه المستشار الخازندار لأنه أصدر حكمًا بسجن أحد الإخوان، ومن بعده قتل الإخوان النقراشى باشا رئيس وزراء مصر، ثم تم القبض على خلية إخوانية وهم فى سيارة جيب يحملون مفرقعات وخططًا لحرق القاهرة، وبدأت النيابة العامة فى التحقيق فى هذه القضية التى عُرفت بقضية السيارة الجيب، ولأن القضية كانت بمثابة مسمار فى نعش الجماعة فى هذا العهد لذلك حاولت الجماعة التخلص من أدلتها، فتحرك النظام الخاص وقام بمحاولة لتفجير المحكمة التى يوجد بها ملف القضية، وانكشف الأمر أمام جهات التحقيق والرأى العام، وأمام هذه المشكلة الكبيرة قام حسن البنا بإصدار بيان يتبرأ فيه ممن قاموا بهذا الفعل وقال فى بيانه عنهم إنهم «ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين»، وعندما وصل خبر هذا البيان للإخوانى الذى قتل محمود فهمى النقراشى، رئيس وزراء مصر، ما كان منه إلا أن بادر إلى الاعتراف الكامل بجريمته وبالمحرضين والمساهمين والمشتركين معه، وعن هذا البيان ونفسية القاتل عبدالمجيد أحمد يقول محمود الصباغ، أحد كبار رجال النظام الخاص: «وقد هللت أجهزة الحكومة مدعية أن الغرض كان نسف المحكمة، وبالغت أبواق الاتهام تهيئ الجو للقضاء التام على الإخوان المسلمين، مما اضطر المرشد العام إلى إصدار بيانه (ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين) ليساعد على تخفيف حدة الضغط على الإخوان، وهو أمر جائز شرعًا فى الحرب ويُعد من خُدعه، كما أوضحنا عند ذكر سرايا رسول الله ﷺ لاغتيال أعداء المسلمين، ولكن الأخ عبدالمجيد أحمد حسن لم ينتبه إلى ذلك، وتأثر بالبيان تأثرًا قاده إلى الاعتراف على إخوانه».
هذا هو الرأى الذى وضعه محمود الصباغ تبريرًا لبيان حسن البنا «ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين»، كلماته واضحة بأن حسن البنا استخدم التقية، أو الخداع والكذب، ثم يقول إن التقية هنا جائزة لأنها «أمر جائز فى الحرب»، وأجرى محمود الصباغ، القطب الإخوانى التاريخى، مقارنة فقهية بين قتل الإخوان لمحمود فهمى النقراشى، المصرى المسلم الوطنى الذى كان من قادة الشباب فى ثورة 1919، وبين سرايا أرسلها الرسول ﷺ لقتال أعداء المسلمين، وعاب الصباغ على عبدالمجيد أنه لم يفهم التقية وغابت عنه فاعترف([3])!
هذا كان نموذجًا للتطبيق العملي لمبدأ التقية عند الجماعة الإرهابية في التاريخ الذهبي لها، ومع ذلك فقد سبقت هذه الحادثة حوادث، ولحقتها أخرى، وأما بالنسبة للفتوى التي بين أيدينا فنرى فيها تطبيقًا واضحًا لهذا المبدأ.
فيؤكد القرضاوي مرارًا أن القضية ليست قضية مرشح إسلامي وغير إسلامي، القضية قضية مرشح مؤمن بالثورة ومرشح غير مؤمن بها- يقصد أحداث يناير-، وهذا الكلام قاله مغازلة وجذبًا لجميع التيارات السياسية الأخرى كالتيار الليبرالي بل وحتى الإخوة المسيحيون حتى يتضامنوا مع جماعته وينتخبوا مرشحها.
والحقيقة أن هذا كذب أقرع لعدة أمور:
أولها أن الجماعة الإرهابية لم تكن هي التي قامت بالتظاهر في يناير 2011م، ولم تكن هي صاحبة الدعوى للخروج، ولكنها شاركت فيها في آخر أمرها على استحياء، لأنها وجدت مصلحة في ذلك.
ثانيها أن هذا يخالف دعواهم في كل وقت وزمان من أنهم يسعون إلى تطبيق الشريعة وإلى إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، بل ومن اسمهم تظهر خلفيتهم الدينية.
ثالثها أن هذا يخالف ما سبق وقاله مفتي الفتنة في حق مرشح جماعته من أنه يعرف الله وأنه رجل خيِّر إلى آخر ذلك، فلو كان الأمر بين من هو مناصر لثورة أو معارض لها فما هو الداعي من ذكر هذا الكلام في البداية؟!
5- بث روح الفرقة بين طوائف المجتمع.
يسعى الفكر المتطرف دائمًا في صناعة معسكرين، ولا يعترف بالمنطقة الرمادية، بالرغم أن التيارات المتطرفة بحكم الوقائع والتاريخ هي أكثر التيارات تلونًا، هذان المعسكران يرمزان للخير وللشر، يصبح الفريق المتطرف نزيلًا دائمًا وعضوًا مستمرًا في معسكر الخير، وما عادا ذلك فكل الأمور متاحة، فحبيبه اليوم عدوٌ لله ورسوله غدًا، فقط إذا اقتضت مصلحته ذلك.
وهذا واضح جدًّا في تلك الفتوى أيضًا، فالجماعات المتطرفة التي ملأت الدنيا بمطالباتها لتطبيق الشريعة، تحالف، أو تغازل على أقل تقدير، التيارات الليبرالية التي تنطلق من خلفية لا علاقة لها بالدين فقط لأن ذلك يكثر سوادهم.
كما أن الخلاف بين وجهات النظر في مثل تلك الأمور كالانتخابات لابد أن يكون نزيهًا، لكن مفتي الدم كان دائمًا يكرر كلمة (المعركة الانتخابية)، وهذه الكلمة قد يُظَن أنها مجرد كلمة مجازية عادية، لكن الحرب التي شنها المتطرفون ضد جميع خصومهم وعلى كافة الأصعدة عقب خروج الأمر من أيديهم تشهد أن الكلمة لم تكن كلمة عادية ولم تذكر في الفتوى اعتباطًا.
بل خرجت من فم مفتي الدم معبرة عن منهج وعن فكر بُنِيت عليه الجماعات المتطرفة وتلتزم به ولا تغادره أبدًا وإن ادَّعت خلاف ذلك.
وهذا عرض مختصر لمظاهر التطرف الفكري والمنهجي في تلك الفتوى.
ثانيًا: الجانب الفقهي:
نلاحظ في فتوى القرضاوي (جواز الحلف كذبًا وأخذ الرشوة في الانتخابات)، ملاحظات في غاية الأهمية:
الأولى: أن الفتوى وإن كانت شاذة وغريبة في نفسها أو بالنظر إلى القواعد الفقهية المنضبطة، لكنها ليست كذلك مقارنة بالمقطع المرئي المسجل لها، فالفتوى متسقة تمام الاتساق مع ما قبلها وما بعدها من فتاوى أخرى، فقد سبقت تلك الفتوى الإفتاء بوجوب اختيار شخصًا معينًا من المرشحَين، وبحرمة العكس، ثم يفتي بجواز أخذ الرشوة الانتخابية، ثم يفتى بجواز الحلف كذبًا على النحو الذي فصلناه قبل ذلك، ثم يدعو جميع المصريين من شتى التيارات السياسية والمعتقدات الدينية للتكاتف يدًا بيد لانتخاب مرشح جماعته، ثم في جملة واثقة يؤكد على أنه مؤمن بأن الله سينصر الحق وأن مرشحه سينتصر ولكن هو لا يريد لأحد أن يتخلف عن نصرته([4])!!
الملاحظة الثانية: أنه في الوقت الذي يؤكد فيه على أن تلك المعركة كما يوصِّفها لا يجب أن يدخل فيها المال، وأنه يجب أن تكون لله، ويلوم بل ويهجو المرشح الفاسد لأنه يستثمر أمواله في شراء أصوات الناخبين- على حد زعمه- يقول أيضًا أنه على كل الفئات المصرية التي لا تريد للنظام الفاسد البائد أن يعود عليها أن تضع قوتها وصوتها وكل ما تملكه لصالح مرشح جماعته([5])!!
الملاحظة الثالثة: أن الفتوى ليست على إطلاقها، فجواز الحلف وأخذ الرشوة الانتخابية مقيد بما إذا كان الحالف أو المرتشي سيخدم الجماعة، وسينتخب مرشحها، لا العكس!
حتى لو أبر بقسمه يكون آثمًا على أخذ الرشوة والحلف واختيار الشخص الفاسد الشرير!
وإننا في هذا الجزء نحلل فقهيًّا تلك الفتاوى وعلى ماذا بُنيت وما هو المسوغ الشرعي لها؟
1- جواز الحلف بالله كذبًا.
ونقدم الكلام عليها لأنها موضوع البحث، فنقول وبالله التوفيق:
أفتى القرضاوي بجواز الحلف بالله كذبًا في الانتخابات في حالة ما إذا كان الحالف اضطر لهذا الحِلف، وصورة ذلك أنه قبض من بعض الممولِين مالًا على أنه سيختار مرشحًا بعينه وهو هنا المرشح الفاسد من وجهة نظر المفتي المتطرف، ثم أراد الممول التأكد من أنه سيختار ما أخذ المال لأجل اختياره فاستحلفه فحلف بالله ليفعلن، فيفتيه القرضاوي بجواز أن يحلف هذا الحلف ولا يبر به لأنه قسم على معصية، والمعصية هي اختيار الشخص غير الصالح للمنصب المتنافس عليه.
ومن هذا الكلام يظهر أن جواز هذا الحلف الكاذب- في فتوى القرضاوي- مبني على أن ذلك الحِلف حلف على معصية، وإلا فلا يجوز الحلف كذبًا.
واستشهد على صحة فتواه هذه بقوله تعالى: ﴿ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [البقرة: 224].
على أن تفسيرها كما ذكره القرطبي قال: «قال العلماء: لما أمر الله تعالى بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء بجميل المعاشرة قال: لا تمتنعوا عن شي من المكارم تعللًا بأنا حلفنا ألا نفعل كذا، قال معناه ابن عباس والنخعي ومجاهد والربيع وغيرهم. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يحلف ألا يبر ولا يصل ولا يصلح بين الناس، فيقال له: بر، فيقول: قد حلفت»([6]).
وبهذا المعنى يقول الإمام البيضاوي: «نزلت في الصديق رضي الله تعالى عنه لما حلف أن لا ينفق على مسطح لافترائه على عائشة رضي الله تعالى عنها، أو في عبد الله بن رواحة حلف أن لا يكلم ختنه بشير بن النعمان ولا يصلح بينه وبين أخته. والعرضة فعلة بمعنى المفعول، كالقبضة تطلق لما يعرض دون الشيء وللمعرض للأمر، ومعنى الآية على الأول ولا تجعلوا الله حاجزًا لما حلفتم عليه من أنواع الخير، فيكون المراد بالإِيمان الأمور المحلوف عليها، كقوله عليه الصلاة والسلام لابن سَمُرَة «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك»([7]). وأن مع صلتها عطف بيان لها، واللام صلة عرضة لما فيها من معنى الاعتراض، ويجوز أن تكون للتعليل ويتعلق أن بالفعل أو بعرضة أي ولا تجعلوا الله عرضة لأن تبروا لأجل أيمانكم به»([8]).
2- جواز أخذ الرشوة الانتخابية.
أفتى القرضاوي بحِل أخذ الرشوة الانتخابية بشرط وهو اختيار المرشح الصالح، وهو مرشح جماعته، وإلا فإن الرشوة تكون حرامًا، ويتضاعف عليه الإثم.
وبنى هذه الفتوى على الترخص للحاجة والضرورة، وقد نص العلماء على هاتين القاعدتين الفقهيتين بقولهم: الضروريات تبيح المحظورات([9])، والحاجة تنزل منزلة الضرورة([10]).
حيث أن الإنسان قد يكون فقيرًا في حاجة إلى هذا المال، فيضطر ليأخذه ويخدع الراشي وينتخب مرشح الجماعة الإرهابية!
ونظيره جواز أكل الميتة عند المخمصة، قال تعالى: ﴿ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [المائدة: 3]، وجواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، قال تعالى: ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [النحل: 106].
3- وجوب اختيار مرشح الجماعة وعدم جواز اختيار المرشح المنافس.
أفتى مفتي الفتنة بوجوب اختيار مرشح الجماعة وعدم جواز اختيار المرشح المنافس، ومبنى هذه الفتوى على استنتاج استنباطي وصورته هي:
- مرشح الجماعة صالح، المرشح المنافس فاسد
- يجب انتخاب المرشح الصالح، ولا يجوز انتخاب المرشح الفاسد
- إذًا يجب انتخاب مرشح الجماعة، ولا يجوز انتخاب المنافس الفاسد!!
والقاعدة العقلية تقول: إذا فسدت المقدمات فسدت النتائج، ونحن في هذا المقام يكفينا أن نشير أننا إن سلمنا بشيء من التسمح لصحة إحدى المقدمتين، وهي المقدمة الثانية، فإننا نحكم بفساد المقدمة الأولى بدون أدنى شك، وعليه فالنتيجة فاسدة قطعًا.
الرد على الفتوى:
1- جواز الحلف كذبًا في الانتخابات.
أفتى القرضاوي كما مر بجواز الحلف كذبًا في الانتخابات، إذا كان الحلف على اختيار المرشح الفاسد وهو المنافس لمرشح جماعته الصالح كما وصفهما على حد زعمه، وخَرَّج هذه الفتوى على أنها حلف على معصية، والحلف على المعصية لا يجوز الإبرار به.
والجواب على هذا من وجهين:
- الوجه الأول: أن هذه اليمين ليست يمين على معصية، وبالتالي الإيفاء بها واجب شرعًا، وبيان ذلك من أربعة طرق:
- الأول: إن القانون المصري قد ضمن نزاهة كل من المرشحين واستيفاءهم لكافة شروط الترشح، وبالتالي فللناس كامل حرية الاختيار بينهما، ومسألة الاختلاف في الأجندات أو المذهب السياسي إن صح التعبير لا يعني صلاح أحدهم أو فساد الآخر، وبالتالي ليست هناك ثمة معصية في اختيار أحد المرشحين، نعم؛ هناك دائمًا اختيار خاطئ واختيار صائب، لكن المسألة نسبية مبنية على إيدلوجية سياسية ولا تصل بحال من الأحوال إلى الحلال والحرام مادامت داخل إطار القانون. وعليه فالقسم ليس قسم على معصية ويجب الإيفاء به وذلك لقوله تعالى: ﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [المائدة: 89]. وهذه اليمين يمين منعقدة وليست من باب اللغو.
- الثاني: إن مرشح جماعة اتخذت الدين مطية للوصول إلى مآربها الشخصية، وأصل منظِّروها الفكريون لمبادئ وأفكار التطرف ابتكارًا واختراعًا كسيد قطب وأمثاله، مما أدى إلى تضليل أناس كثيرين، وصدهم عن سبيل الله، جماعة لم تراع في سبيل تحقيق أهدافها الخسيسة حرمة النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فمنذ عهد المؤسس إلى يومنا هذا ويدها مازالت تلوث بدماء الأبرياء، ومالأت الفُرقاء، وداهنت الأغنياء والوجهاء، واحتالت لأكل أموال الناس بالباطل، وسعت لخلخلة الأنظمة ونشر الفوضى، وكل ذلك في تاريخ مدون على يد أعضاء الجماعة أنفسهم -لهو أحرى الناس بأن يوسم بالاختيار الخاطئ لا غيره وهذا على أقل تقدير!
ومن ثم فاليمين ليست يمين على معصية والأجدر أن يقال العكس، لكننا لا نفتي بذلك، فالحلال والحرام أجل من أن يستخدم لتحقيق أهداف شخصية ومطامح نفسانية.
- الثالث: إن سريرة المرء وعلاقته بربه ليست محلًّا للتقييم من قبل الناس مطلقًا، وذلك لأسباب؛ أولها أن البشر عاجزون عن إدراك ما في قلوب بعضهم البعض، وانفرد الله سبحانه وتعالى بعلم ذلك، فقال سبحانه: ﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [غافر: 19]، وفي هذه الآية إشارة إلى أن العباد مع عجزهم عن الاطلاع عما في قلوب العباد عاجزين أيضًا عن الإحاطة والمعرفة الكاملة بكل ظواهرهم، ومن ذلك على سبيل المثال خائنة الأعين، وهي وهي النظرة المريبة أو المختلسة([11])، ثاني تلك الأسباب أننا لم نؤمر بذلك، بل أمرنا بعكسه، فقد أخرج الإمامين البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إني لم أومر أن أنقُبَ عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم»([12])، قال القاضي عياض: «قوله لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس: كذا لابن ماهان، ولبعضهم أنقب بفتح النون وشد القاف بمعنى أبحث وأفتش، والأول أولى لأنه بمعنى الشق، كما قال في الحديث الآخر فهلَّا شققت عن قلبه، واللفظان راجعان لمعنى واحد»([13])، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ﷺ وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرًا، أمنَّاه، وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة»([14])، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «أن الشافعي قال في كلام له: وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر، والله متولي السرائر، وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر»([15]).
وعلى ذلك فمسألة الحكم على الخلق بالصلاح والفساد، ليس من عمل البشر، لكن قد يضطر القاضي مثلًا ونحوه للحكم على بعض الناس ويكون الحكم نسبي لا حقيقي مطلق، لإن الله هو وحده علام الغيوب المطلع على سرائر الخلق، وإن النبي ﷺ الذي قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى: ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [التوبة: 18] الآية»([16])، ورد عنه أيضًا أنه قال: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئًا، وينظر في القدح فلا يرى شيئًا، وينظر في الريش فلا يرى شيئًا، ويتمارى في الفوق»([17])، قال ﷺ ذلك واصفًا الخوارج، وفيه دليل ظاهر على اهتمامهم بالعبادات الظاهرة مع خراب وفساد دواخلهم.
ومن ثم فالحكم على شخص ما لأنه ينسب لجماعة إسلامية معينة- وهي ذاتها نفس الجماعة التي أنتسب لها صاحب الفتوى- بأنه شخص صالح وخير، ومنافسه بالفساد لأنه لا ينتسب لهذه الجماعة حكم سطحي وساذج، وفيه من المحاباة ما فيه، وبالتالي فهو حكم ساقط، وعليه فليس انتخاب المنافس لمرشح جماعة القرضاوي معصية، والحلف على انتخابه يمين منعقدة يجب الإيفاء بها.
- الرابع: مسألة صلاح الشخص ومعرفته بربه ليست هي ما عليه المعول في مثل تلك الأمور، هذا إن سلمنا أنه يمكن معرفة ذلك والاطلاع عليه، وقد أفرد الشيخ ابن تيمية فصلًا في هذا المعنى، فكان مما قال: «اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، ولهذا كان عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- يقول: «اللهم أشكو إليك جلد الفاجر، وعجز الثقة». فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة: قدم أنفعهما لتلك الولاية، وأقلهما ضررًا فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع- وإن كان فيه فجور- على الرجل الضعيف العاجز، وإن كان أمينًا؛ كما سئل الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؛ فقال: أما الفاجر القوي، فقوته للمسلمين، وفجوره على نفسه؛ وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. فيغزي مع القوي الفاجر. وقد قال النبي ﷺ: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»([18]). وروي «بأقوام لا خلاق لهم»([19]) . وإن لم يكن فاجرًا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده، ولهذا كان النبي ﷺ يستعمل خالد بن الوليد على الحرب، منذ أسلم، وقال: «إن خالدًا سيف سله الله على المشركين»([20]) . مع أنه أحيانًا قد كان يعمل ما ينكره النبي ﷺ، حتى إنه مرة قام ثم رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد»([21]) لما أرسله إلى بني جذيمة فقتلهم، وأخذ أموالهم بنوع شبهة، ولم يكن يجوز ذلك، وأنكره عليه بعض من معه من الصحابة، حتى وداهم النبي ﷺ، وضمن أموالهم؛ ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب؛ لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره، وفعل ما فعل بنوع تأويل. وكان أبو ذر- رضي الله عنه- أصلح منه في الأمانة والصدق؛ ومع هذا قال له النبي ﷺ: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم»([22]). رواه مسلم. نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفًا مع أنه قد روي: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»([23]) وأمر النبي ﷺ مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل- استعطافًا لأقاربه الذين بعثه إليهم- على من هم أفضل منه. وأمر أسامة بن زيد؛ لأجل طلب ثأر أبيه. وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة، مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله ﷺ-رضي الله عنه- ما زال يستعمل خالدًا في حرب أهل الردة، وفي فتوح العراق والشام، وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل، وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى، فلم يعزله من أجلها؛ بل عاتبه عليها: لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه، وأن غيره لم يكن يقوم مقامه؛ لأن المتولي الكبير، إذا كان خلقه يميل إلى اللين، فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة؛ وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة، فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين؛ ليعتدل الأمر. ولهذا كان أبو بكر الصديق-رضي الله عنه- يؤثر استنابة خالد؛ وكان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يؤثر عزل خالد، واستنابة أبي عبيدة بن الجراح- رضي الله عنه- لأن خالدًا كان شديد، كعمر بن الخطاب وأبا عبيدة كان لينًا كأبي بكر؛ وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه؛ ليكون أمره معتدلًا، ويكون بذلك من خلفاء رسول الله ﷺ الذي هو معتدل؛ حتى قال النبي ﷺ: «أنا نبي الرحمة، أنا نبي الملحمة»([24])... إلخ»([25]).
وعلى ذلك فلو سلمنا جدلًا أن مرشح الجماعة الإرهابية رجل ظاهر الصلاح كما زعمه القرضاوي في فتواه، والآخر رجل فاسد، فالعبرة بمن هو أصلح للمنصب وأقدر عليه، لا بمن يحافظ على صلاة الجماعة ويقوم الليل، وبالتالي فالأمر نسبي ومطلق، وللناخب حرية الاختيار، وليس اختيار أحدهما معصية لله عز وجل، وبالتالي يجب الإبرار بالقسم شرعًا.
- الوجه الثاني:
وهو إذا سلمنا جدلًا أن انتخاب المرشح المنافس لمرشح الجماعة الإرهابية معصية لله عز وجل!!
فنقول مستعينين بالله عز وجل أن الحلِف لغة بمعنى القسم، قال الجوهري في الصحاح: «حَلَفَ أي أقسم، يَحْلِفُ حَلْفًا وحَلِفًا ومَحْلُوفًا»([26]).
وقال محمد بن أبي بكر الرازي في مختار الصحاح: «و(أقْسَم) حَلَفَ وأصله من (القَسَامة) وهي الأَيْمَان تُقْسَم على الأولياء في الدم. و(القَسَم) بفتحتين اليمين وكذا المُقْسَم و(هو) مصدر كالمُخرج. و(المُقسَم) أيضًا موضع القَسَم. و(قاسمه) حَلَفَ له»([27]).
وأما اليمين في الشرع فذكر معناها الشريف الجرجاني وذكر أقسامها، فقال: «اليمين: في اللغة: القوة، وفي الشرع: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو التعليق؛ فإن اليمين بغير الله ذكر الشرط والجزاء، حتى لو حلف أن لا يحلف، وقال: إن دخلت الدار فعبدي حر يحنث، فتحريم الحلال يمين، كقوله تعالى: ﴿ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾. اليمين الغموس: هو الحلف على فعل أو ترك ماضٍ كاذبًا. اليمين اللغو: ما يحلف ظانًا أنه كذا وهو خلافه، وقال الشافعي رحمه الله: ما لا يعقد الرجل قلبه عليه، كقوله: لا والله، وبلى والله. اليمين المنعقدة: الحلف على فعل أو ترك آت. يمين الصبر: هي التي يكون الرجل فيها متعمدًا الكذب، قاصدًا لإذهاب مال مسلم، سميت به لصبر صاحبه على الإقدام عليها، مع وجود الزواجر من قبله»([28]).
وإننا إذا تأملنا في هذه الأقسام، وتأملنا في الفتوى لوجدنا أن القرضاوي اعتبر هذه اليمين يمين منعقدة، ولما كانت على معصية- من وجهة نظره- أفتى بوجوب عدم العمل بها، وهذا تخريج خاطئ من كل وجه.
الأول: أننا إذا اعتبرنا أن الناخب حلف قبل أن يسمع تلك الفتوى على أن ينتخب فلانًا، وهو المنافس لمرشح جماعته، ثم سمع الفتوى وأراد ألا ينتخب من حلف أنه سينتخبه- وهذه صورة نادرة الحدوث- فقد اتفق الفقهاء جميعًا على أنه يجب عليه الكفارة، وهو ما لم يأت القرضاوي على ذكره!
قال الإمام الحصكفي الحنفي في أول كتاب الأيمان: «وشرطها: الإسلام، والتكليف، وإمكان البر. وحكمها: البر أو الكفارة. وركنها: اللفظ المستعمل فيها».
قال ابن عابدين في حاشيته: «(قوله وحكمها البر أو الكفارة) أي البر أصلًا والكفارة خلفًا كما في الدر المنتقى. وأنت خبير بأن الكفارة خاصة باليمين بالله تعالى ح وأراد البر وجودًا وعدمًا، فإنه يجب فيما إذا حلف على طاعة، ويحرم فيما إذا حلف على معصية، ويندب فيما إذا كان عدم المحلوف عليه جائزًا وفيه زيادة تفصيل سيأتي»([29]).
وقال ابن رشد الحفيد المالكي: «اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة هل الكفارة سواء أكان حلفًا على شيء ماض أنه كان فلم يكن وهي التي تعرف باليمين الغموس وذلك إذا تعمد الكذب أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن، فقال الجمهور: ليس في اليمين الغموس كفارة وإنما الكفارة في الأيمان التي تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي وجماعة: يجب فيها الكفارة أي تسقط الكفارة الإثم فيها كما تسقطه في غير الغموس»([30]).
فالخلاف الجاري بين الفقهاء فيما إذا كانت اليمين يمين غموس، هل تجب فيها الكفارة أو لا؟ ومن أوجب منهم الكفارة فيها فقد أوجب ذلك على أنها من باب اليمين المنعقدة.
قال الخطيب الشربيني الشافعي: «والثانية منعقدة؛ لأنها استدراك فصارت مقصودة، ولو حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره كان من لغو اليمين، وجعل صاحب الكافي من لغو اليمين ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له، فقال: والله لا تقوم. وهو مما تعم به البلوى، ولو ادعى سبق لسانه في إيلاء أو الحلف بطلاق أو عتق لم يقبل ظاهرًا لتعلق حق الغير به.
تنبيه: لا حاجة لقوله: (بلا قصد) بعد قوله: (ومن سبق لسانه).
(وتصح) اليمين (على ماض) كوالله ما فعلت كذا أو فعلته بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [التوبة: 74] ثم إن كان عامدًا فهي اليمين الغموس، سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي من الكبائر، وتتعلق بها الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة، لقوله تعالى: ﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [المائدة: 89] وهو يعم الماضي والمستقبل، وتعلق الإثم لا يمنع الكفارة كما أن الظهار منكر من القول وزور وتتعلق به الكفارة، بل وفيها التعزير أيضًا كما مر في فصل التعزير أنها مستثنى من قولهم: يعزر كل معصية لا حد فيها ولا كفارة»([31]).
الثاني: أن الناخب سمع الفتوى ثم أراد أن يعمل بها، فتوجه وحلف بالله أنه سينتخب فلانًا وهو جازم في باطنه أنه لن ينتخبه، فهذه يمين غموس فاجرة، وهي اليمين الكاذبة عمدًا في الماضي أو الحال أو الاستقبال، سواء أكانت على النفي أم على الإثبات([32]).
وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس»([33]).
وهي يمين الصَّبْر، وقد أخرج فيها الشيخان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان»([34]).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابًا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابًا من البغى وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقِع»([35]). وبلاقع يعني قَفْر لا شيء فيها([36]).
وهذا بغض النظر عن أن الناخب يرى أن انتخابه لمنافس مرشح الجماعة معصية أو لا، لأنه لو كان يرى أنها معصية وهو في باطنه لا ينوي فعلها لكنه حلف مختارًا غير مكره أنه سيفعلها، فهو متلاعب بيمين الله عز وجل بالإضافة إلى كذبه، فهذا ذنب مضاعف، وقد قال تعالى: ﴿ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [البقرة: 225]، وقال تعالى: ﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [آل عمران: 77].
قال الطبري في تفسيره: «- حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال، حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن منصور قال: قال إبراهيم: (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)، قال: أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، فذاك الذي يؤاخذ به.
- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن إبراهيم:(ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)، أن تحلف وأنت كاذب.
- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) [سورة المائدة: 89]، وذلك اليمين الصبر الكاذبة، يحلف بها الرجل على ظلم أو قطيعة، فتلك لا كفارة لها إلا أن يترك ذلك الظلم، أو يرد ذلك المال إلى أهله، وهو قوله تعالى ذكره: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا) إلى قوله: (ولهم عذاب أليم) [سورة آل عمران: 77] .
- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)، ما عقدت عليه»([37]).
والواقع أنه ما فعل ما فعل إلا لأجل استبقاء ذلك المال الذي أخذه معه، وهو مال الرشوة الذي سبق وذكرنا الكلام عنه، وسيأتي الكلام تفصيلًا عليه، وهذه هي عين يمين الغموس الفاجرة التي يحلفها لأجل أخذ مال لا يحل له.
والحق أنه لا يجوز له الحلف على فعل معصية أصلًا، على فرض أنها معصية جدلًا، ولا يجوز له قبول مال على فعلها.
ولو قبض ذلك المال وحلف على فعل المعصية، فيجب عليه رد هذا المال إلى صاحبه، والتكفير عن هذا اليمين، أو الاستغفار عسى الله أن يغفر له، على الخلاف الجاري بين العلماء في كفارة اليمين الغموس.
وأما فتوى القرضاوي هذه فقد أبعد فيها النُّجعة، فاخترع وقال ما لم يقله أحد من الأئمة، ولا قريب من كلامهم، ولا يشبهه، حيث أفتى بجواز الحلف كذبًا وقبض المال كأجر على فعل المعصية!
وبالتأمل، يظهر أن الصورة الوحيدة التي يمكن قبول مثل ذلك الكلام في إطارها، هي أن الذي يدفع المال هذا، وهو المنافس لمرشح الجماعة الإرهابية، سواء دفع هذا المال بالأصالة أو بالنيابة، كافرٌ حربيٌّ حلال الدم والمال، فيمكن في هذه الحال تصور أن هذا جائز من باب الخدعة!
والحقيقة أن هذا الكلام لم يجرؤ القرضاوي على قوله والاعتراف به، لأنه سيكون تكفيرًا صريحًا للمسلمين، في الوقت الذي يدعون فيه أنهم دعاة للوسطية وللإسلام السمح.
ومع ذلك فهذا الفرض ليس جديدًا عليهم، فهم يبنون دائمًا فتاواهم على هذا التصور وإن لم يصرحوا به، وقد ذكرنا جانبًا من هذا في تبرير محمود الصباغ لفتاوى حسن البنا!
ويمكننا أن نختم هنا بفتوى رصينة لأحد أكابر المشايخ، وهو الشيخ حسن مأمون، وأصدر تلك الفتوى عام 1957م، عن سؤال ورد إليه، متضمنه: «أن بعض المرشحين لمجلس الأمة يلجأ لوسائل متعددة للحصول على أيمان من الناخبين بتحليف الناخب بالله العظيم ثلاثًا، أو بتحليفه على المصحف، أو بتحليفه على البخاري، بأنه سيمنح صوته عند الانتخاب لمرشح معين، والمطلوب الإفادة عن حكم الدين فيما إذا أقسم مواطن على المصحف، أو يقسم آخر على إعطاء صوته لشخص معين واتضح له بينه وبين ضميره أن المرشح الذي أقسم على انتخابه ليس أصلح المرشحين ولا أكفأهم للنيابة. فهل يحافظ على القسم الذي قطعه على نفسه، وينتخب من أقسم على انتخابه وهو يعلم أنه ليس أصلح المرشحين؟ أو يلبي نداء ضميره وينتخب أصلح المرشحين ولو تعارض مع قسمه؟».
فأجاب الشيخ: «إن عضوية مجلس الأمة من المناصب الهامة والولايات العامة التي لا يجوز أن تقلَّد لغير أهلها ولمن لا يصلح لها، فمن الواجب شرعًا على كل ناخب ألا يراعي في الانتخاب لهذا المنصب غير المصلحة العامة دون تأثر بأي مؤثر، فينتخب الأكفأ الأصلح، ولا يمكن من هو دون ذلك منه؛ لأن اختيار الأصلح أمانة، فإذا ضيعها باختيار غير الأصلح كان ساعيًا في ضرر الجماعة، والضرر غير جائز شرعًا؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار»([38]) رواه ابن ماجه.
فإذا استحلفه أحد المرشحين بالله أو على المصحف على إعطائه صوته فحلف، ثم تبيَّن له أن منافسه هو الصالح أو الأصلح حقًّا دون من استحلفه وجب عليه أن ينتخب المنافس ويُكفِّر عن يمينه، وكان الحِنث في هذه الحالة واجبًا، والتمادي في اليمين معصية؛ وذلك لأن الحنث في اليمين مشروعٌ إذا كان خيرًا من التمادي فيه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» رواه مسلم، وفيه دليل على أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي فيه إذا كان في الحنث مصلحة.
ويختلف ذلك باختلاف المحلوف عليه؛ فإن حلف على فعلِ أمرٍ واجب، أو تركِ حرامٍ: فيمينه طاعة، والتمادي فيه واجب، والحنث معصية، وإن حلف على فعلِ أمرٍ محرم، أو تركِ أمرٍ واجب: فيمينه معصية، والتمادي فيه حرام، والحنث طاعة، وهذا إذا كان الحلف بالله، أو على المصحف، أما إذا كان الحلف بغير ذلك فلا يكون يمينًا؛ لأن الحلف شرعًا لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه.
والله سبحانه وتعالى أعلم»([39]).
2- جواز أخذ الرشوة الانتخابية.
أفتى مفتي الفتنة بحِل أخذ الرشوة الانتخابية بشرط وهو اختيار مرشح جماعته، وإلا فإن الرشوة تكون حرامًا، ويتضاعف عليه الإثم.
ودليله في ذلك أن هناك من الناس من يحتاج لهذه الأموال لأنه لا يجد أو لأنه من أصحاب المهن الشاقة!
وقد نص الفقهاء في كتب الأصول على قاعدتين فقهيتين تتعلقان بهذا الشأن: الأولى هي: الضروريات تبيح المحظورات([40])، والثانية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة([41]).
وقال الجرجاني في التعريفات: «الضرورة: مشتقة من الضرر، وهو النازل مما لا مدفع له»([42]).
وقيل أن الضروري هو ما تدعو الحاجة إليه لرفع الضرر النازل بأحدى الضروريات الخمس، والضروريات الخمس هي حفظ النفس والدين والعقل والعرض والمال([43]).
وأما الحاجة فهي: ما تكون حياة الانسان دونها عسرة شديدة([44]).
ومن أجود ما قيل أن الحاجة هي ما يفتقر الإنسان إليه مع أنه يبقى بدونه، والضرورة ما لابدَّ له في بقائه، والفضولُ بخلافهما([45]).
وقد فصل الإمام الشاطبي في التفرقة بين الضروريات والحاجيات والتحسينات بكلام بديع، فقال: «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية.
فأما الضرورية، فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود، كالإيمان. والنطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وما أشبه ذلك. والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضًا، كتناول المأكولات والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك.
والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا، لكن بواسطة العادات.
والجنايات- ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. والعبادات والعادات قد مثلت، والمعاملات ما كان راجعًا إلى مصلحة الإنسان مع غيره، كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع، والجنايات ما كان عائدًا على ما تقدم بالإبطال، فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال، ويتلافى تلك المصالح، كالقصاص، والديات للنفس، والحد للعقل، وتضمين قيم الأموال للنسل والقطع والتضمين للمال، وما أشبه ذلك.
ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة.
وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.
وهي جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات: ففي العبادات: كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر، وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال، مأكلًا ومشربًا وملبسًا ومسكنًا ومركبًا، وما أشبه ذلك.
وفي المعاملات، كالقراض، والمساقاة، والسلم، وإلقاء التوابع في العقد على المتبوعات، كمثرة الشجر، ومال العبد.
وفي الجنايات، كالحكم باللوث، والتدمية، والقسامة، وضرب الدية على العاقلة، وتضمين الصناع، وما أشبه ذلك.
وأما التحسينات، فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق.
وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان: ففي العبادات، كإزالة النجاسة- وبالجملة الطهارات كلها- وستر العورة، وأخذ الزينة، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات، وأشباه ذلك. وفي العادات، كآداب الأكل والشرب، ومجانبة المآكل النجسات والمشارب المستخبثات، والإسراف والإقتار في المتناولات.
وفي المعاملات، كالمنع من بيع النجاسات، وفضل الماء والكلأ، وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة، وسلب المرأة منصب الإمامة، وإنكاح نفسها، وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبير، وما أشبهها.
وفي الجنايات، كمنع قتل الحر بالعبد، أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد.
وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناها، فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية، إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين»([46]).
وأما الرِّشوة؛ وهي ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وجمعها رِشًا مثل: سِدْرة وسِدَر والضم لغة، وجمعها رُشًا بالضم أيضًا([47])، فهي في الحكم وللمسئول عن عمل حرام بلا خلاف، ومن الكبائر([48]).
وذلك لقول الله تعالى: ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [البقرة: 188]، وقوله عز وجل: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [المائدة: 42]، قال ابن جرير الطبري: «حدثني المثنى قال، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال، حدثنا أبو عقيل قال، سمعت الحسن يقول في قوله: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾، قال: تلك الحكام، سمعوا كِذْبَةً وأكلوا رِشْوَةً.
- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾، قال: كان هذا في حكّام اليهودِ بين أيديكم، كانوا يسمعون الكذب ويقبلون الرُّشَى.
- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: ﴿ ﭓ ﭔ﴾، قال: الرشوة في الحكم، وهم يهود»([49]).
وصح عن النبي ﷺ أنه قال: «لعنة الله على الراشي والمرتشي»([50]).
قال في العرف الشذي شرح سنن الترمذي: «الرشوة في اللغة إدلاء الدلو في البير، وقال فقهاؤنا: يجوز إعطاء الرشوة إذا كان مظلومًا، وإن كان ظالمًا أو كان له غرض فاسد فلا يجوز، والراشي المعطي، والمرتشي الآخذ، ووقع في بعض كتب اللغة حديث: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»([51]) إلخ، والرائش الوكيل بين الراشي والمرتشي، وأحاديث أرباب اللغة لا تكون بلا أصل، وذكر العسكري إمام اللغة في كتاب الأمثال قريب ألف حديث ليست بلا أصل»([52]).
وبعد هذا العرض اللطيف لمعنى الضرورة والحاجة والرشوة الفقهي وبعض أحكامهم، وبالرجوع إلى الفتوى التي هي محل البحث، نجد أن القرضاوي قال أن بعض الناس يحتاجون لأخذ هذه الرشوة لحاجتهم، فبعض الناس لا يجدون عملًا أو يعملون الأعمال الصعبة الثقيلة ويحتاجون لهذا المال، قال: فيأخذ هذا المال ويختار الأصلح، وإذا أخذ هذا المال واختار السيء فقد ارتكب جريمتين([53])!
ويحسن بنا قبل أن نرد على هذه الفتوى الشاذة، أن نلفت الانتباه إلى أن معنى الحاجة الفقهي الذي ذكرناه آنفًا والذي تترتب عليه أحكام فقهية خاصة، يختلف عن معنى الحاجة في عرف الناس، فالناس قد يطلقون الحاجة ويريدون بها الضروري أو الحاجي أو الكمالي أو حتى الفضولي، وهو أخص أيضًا من معناها اللغوي، فإن الحاجة في اللغة المأربة، والحَوْج الطلب([54]).
وهذا مما لم يبين في الفتوى، فلو كان الإنسان محتاج لهذا المال حاجة تكميلية أو تحسينية، فهذا المال لا يجوز له باتفاق الفقهاء، لأنه يبيع مقابل هذا المال شهادته، والشهادة يجب أن تكون لله عز وجل، قال تعالى: ﴿ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [الطلاق: 2].
وأما إذا كانت حاجته ضرورية بمعنى أنه سيموت جوعًا مثلًا إن لم يقبض هذا المال المحرم، فيجوز في هذا الحالة أخذه هذا المال، عملًا بالقاعدة الفقهية سالفة الذكر: الضروريات تبيح المحظورات([55]).
لكن بشروط ذكرها الفقهاء، يعنينا في هذا المقام منها: أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: «ولذا قال في أيمان الظهيرية: إن اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وإنما يباح التعريض، انتهى. يعني؛ لاندفاعها بالتعريض، ومن فروعه: المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة؛ لأنه إنما أبيح للضرورة. قال في الكنز: وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة، وبعد الخروج منها لا، وما فضل رد إلى الغنيمة. وأفتوا بالعفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني؛ لأنه لا ضرورة في الأواني؛ لجريان العادة بتخميرها. وفرق كثير من المشايخ في البعر بين آبار الفلوات؛ فيعفى عن قليله للضرورة؛ لأنه ليس لها رءوس حاجزة والإبل تبعر حولها، وبين آبار الأمصار؛ لعدم الضرورة، بخلاف الكثير. ولكن المعتمد عدم الفرق بين آبار الفلوات والأمصار، وبين الصحيح والمنكسر، وبين الرطب واليابس. ويعفى عن ثياب المتوضئ إذا أصابها من الماء المستعمل، على رواية النجاسة للضرورة ولا يعفى عما يصيب ثوب غيره؛ لعدمها، ودم الشهيد طاهر في حق نفسه، نجس في حق غيره لعدم الضرورة، والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه، والطبيب إنما ينظر من العورة بقدر الحاجة. وفرع الشافعية عليها؛ أن المجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة؛ لاندفاع الحاجة بها. انتهى، ولم أره لمشايخنا رحمهم الله»([56]).
وظاهر من هذا الكلام أنه لا يجوز له من هذا المال المحرم إلا قدر ما يسد الرمق، وهو ثمن رغيف العيش، لا أكثر!
لكن القرضاوي قال في فتواه الشاذة أنهم يدفعون مئات الجنيهات وأحيانًا ألف جنيه لشراء الصوت الواحد([57])، ومع ذلك أباح الأخذ مطلقًا بلا تنبيه!
وأما إذا أخذ المال على سبيل الاحتياج، على تعريف الحاجة الفقهي، عملًا بالقاعدة الفقهية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة([58])، فقد اختلف المشايخ في حكم ذلك، فإن الذي لم يبح إلا ما يسد الرمق من لحم الميتة للمضطر يلزم من كلامه أن المحتاج لا يأكل منها.
وقد تكلم المشايخ عما إذا تناول المضطر أو المحتاج المحرم، فقال بدر الدين الزركشي: «الضرورة: بلوغه حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعًا أو عريانًا لمات أو تلف منه عضو. وهذا يبيح تناول المحرم.
والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم»([59]).
ثم تكلموا هل يقطع السارق المضطر أو لا يقطع، فقال شمس الأئمة السرخسي: «الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة فيمنع ذلك وجوب القطع»([60]).
وقال في الإمام الشيرازي في المهذب: «وإن سرق الطعام عام المجاعة نظرت إن كان الطعام موجودًا قُطِع؛ لأنه غير محتاج إلى سرقته وإن كان معدومًا لم يقطع؛ لما روي عن عمر- رضي الله عنه- أنه قال: لا قطع في عام المجاعة أو السنة. ولأن له أن يأخذه فلم يقطع فيه»([61]).
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: «الاضطرار شبهة تدرأ الحد، والضرورة تبيح للآدمي أن يتناول من مال الغير بقدر الحاجة ليدفع الهلاك عن نفسه، فمن سرق ليرد جوعًا أو عطشًا مهلكًا فلا عقاب عليه... والحاجة أقل من الضرورة، فهي كل حالة يترتب عليها حرج شديد وضيق بين، ولذا فإنها تصلح شبهة لدرء الحد، ولكنها لا تمنع الضمان والتعزير»([62]).
وابن نجيم الذي ذكر أن الفقهاء لم يجيزوا للمضطر الأكل من الميتة إلا ما يسد الرمق، ذكر في كلامه عن القاعدة الفقهية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ما نصه: «وفي القنية والبغية: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح»([63]).
لكن قال الشيخ ابن تيمية: «وقد أباح الشارع أنواعًا من الغرر للحاجة، كما أباح اشتراط ثمر النخل بعد التأبير تبعًا للأصل وجوز بيع المجازفة وغير ذلك. وأما الربا فلم يبح منه»([64]).
والحاصل أننا لا يمكن أن ندعي أن المشايخ اتفقوا على أن المحتاج احتياجًا شرعيًّا يجوز له الأخذ من هذا المال، وأيضًا لا يمكن أن ندعي عكس ذلك.
وحتى بتقليد من أباح ذلك من العلماء، فيجب عليه ألا يأخذ إلا من يدفع عنه الضيق والعسر الشديد فقط لا أكثر، وهو ما سكتت عنه هذه الفتوى الشاذة أيضًا.
ومن شذوذ هذه الفتوى البالغ، أن الإثم سيكون مرفوعًا عن آخذ الرشوة فقط إذا انتخب مرشح الجماعة، أما إذا لم ينتخبه فيكسب إثمين، إثم أخذ المال وإثم انتخاب الشخص الفاسد، وهو المرشح المنافس لمرشح الجماعة، على حد وصف القرضاوي.
وموطن الانحراف هنا أن هذا المال المحرم أخذه أبيح لآخذه للضرورة أو الحاجة، وقد نص الفقهاء على أن ما جاز لعذر بطل بزواله، قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: «ما جاز لعذر بطل بزواله، فبطل التيمم إذا قدر على استعمال الماء؛ فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه، وإن كان لمرض بطل ببرئه، وإن كان لبرد بطل بزواله»([65]).
وقد نص القرضاوي مفاد تلك القاعدة حينما رخص قبض ذلك المال المحرم كما مر، لكنه مع ذلك يؤثِّم الآخذ من المال على أخذه ذلك المال إذا اختار المرشح المنافس لمرشح الجماعة!
وإذا اختار مرشح الجماعة لا يأثم، فتحكَّم وضم علة إضافية إلى العلة الأصلية، بلا دليل شرعي، وهذا اتباع للهوى وتصرف في دين الله سبحانه وتعالى.
ويظهر من هذه الانحرافات والشذوذات المتراكب بعضها فوق بعض أن هذه الفتوى فتوى ساقطة من كل وجه، حتى لو اعتبر أن المرشح المنافس لجماعته حلال الدم والمال كالكافر الحربي، فكيف يؤثِّم آخذ المال على أخذه المال إن لم يختر مرشح جماعته؟!
وما هو الداعي الشرعي لذكر مسألة الضرورة أو الاحتياج في هذا الباب؟ اللهم إن ذكرها من باب الأكل من الغنيمة في الحرب قبل تقسيمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!
خاتمة:
وختامًا نقول إن اتخاذ الدين مطية لتحقيق الأغراض الدنية، واستغلال محبة الناس لدينهم في السيطرة عليهم واستغلالهم للمصلحة الشخصية، وأخذ أحكام خاصة بالكفار الحربية وجعلها في أمة خير البرية، واتخاذ آيات الله وسنة رسوله ﷺ لعبًا وهزوًا، لهو أسرع طريق لإلباس هذه الأمة ثياب الذلة بعد العزة، ولهو عين الانحراف والتطرف الصارف عن سبيل الله تعالى والصاد، والمسئول عن وجود التطرف المعاكس والمضاد، وقد وجب علينا البيان والمعونة والهداية من الرحيم الرحمن.
وهو من وراء القصد، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
***
([1]) انظر: مقطع مرئي بعنوان (القرضاوي يؤيد مرسي ويفتي بجواز أخذ الرشوة الانتخابية)، منشور على موقع اليوتيوب، بتاريخ: 22/ 7/ 2012م.
([2]) انظر: موجز لكلمة القرضاوي للشعب المصري حول انتخابات رئاسة، منشورة بموقعه الرسمي بتاريخ: 25/ 5/ 2014م.
([3]) انظر: الكذب والتقية عند الإخوان، للأستاذ: ثروت الخرباوي، مقال منشور بموقع العربية الإلكتروني، نشر بتاريخ: 18/ مارس/ 2015م.
([4]) انظر: مقطع مرئي بعنوان (القرضاوي يؤيد مرسي ويفتي بجواز أخذ الرشوة الانتخابية)، منشور على موقع اليوتيوب، بتاريخ: 22/ 7/ 2012م.
([5]) راجع المقطع من الدقيقة: (3:54) إلى (4:24).
([6]) الجامع لأحكام القرآن (3/ 97) للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هـ- 1964م.
([7]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده (6722)، ومسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها... (1652) من حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه.
([8]) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (1/ 140) للإمام أبي سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ.
([9]) انظر: الأشباه والنظائر (ص 84) للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ- 1990م.
([10]) انظر: الأشباه والنظائر (ص 88) للسيوطي.
([11]) انظر: المعجم الوسيط (خ و ن).
([12]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام... (4351)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (1064).
([13]) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2/ 23) للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، المكتبة العتيقة ودار التراث.
([14]) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب الشهداء العدول (2641).
([15]) التلخيص الحبير (4/ 353) للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعة الأولى، 1416هـ- 1995م.
([16]) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة (2617)، وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة (802)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن.
([17]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به (5058)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (1064).
([18]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر (3062)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... (111) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
([19]) أخرجه أحمد (20454) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، والطبراني في الأوسط (1948) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات. انظر: مجمع الزوائد (5/ 302) للإمام الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 1414هـ- 1994م.
([20]) انظر: تاريخ دمشق (72/ 61) للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، تحقيق: عمرو بن غرامة العموري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415هـ- 1995م.
([21]) انظر: السيرة الحلبية (3/ 280) للإمام أبي الفرج نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1427هـ.
([22]) أخرجه مسلم في كتاب الإمامة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (1826) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
([23]) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه (3801)، وابن ماجه في كتاب افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فضل أبي ذر (156)، وأحمد (7078) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
([24]) أخرجه بنحوه أحمد في مسنده (19525)، وابن حبان في صحيحه (6314)، من حديث أبي موسى الأشعري، وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب في أسمائه ﷺ (2355) بدون «نبي الملحمة».
([25]) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص 15، 16، 17) للشيخ أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي الدمشقي، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1418هـ.
([26]) انظر: الصحاح (باب الفاء، فصل الحاء مع اللام).
([27]) انظر: مختار الصحاح (ق س م).
([28]) التعريفات (ص 259، 260) للسيد الشريف علي بن محمد بن علي الزين الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1403هـ- 1983م.
([29]) رد المحتار على الدر المختار (3/ 704) للعلامة محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ- 1992م.
([30]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 409، 410) للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار المعرفة، بيروت- لبنان، الطبعة السادسة، 1402هـ- 1982م
([31]) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (6/ 188) للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ- 1994م.
([32]) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 282) وزارة الشئون الإسلامية بالكويت، دار السلاسل، الكويت، الطبعة الثانية.
([33]) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان، باب اليمين الغموس (6675).
([34]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ [آل عمران: 77] (4549)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (138).
([35]) أخرجه البيهقي في الكبرى (19898)، والطبراني في الأوسط (1092)، والشهاب في مسنده (255)، قال في البدر المنير: رواه إبراهيم بن هانئ، عن أبيه هانئ بن عبد الرحمن، عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعًا. قال: وهذا إسناد متصل ورجاله لم يقدح فيهم، وهو أقرب إلى الصواب. انظر: البدر المنير (8/ 196) للإمام ابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض-السعودية، الطبعة الأولى، 1425هـ- 2004م.
([36]) انظر: مختار الصحاح (ب ل ق ع).
([37]) تفسير الطبري (4/ 450) للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420هـ- 2000م.
([38]) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2341)، من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، والحاكم في المستدرك (2345)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
([39]) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (6/ 2087، 2088) المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمون، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- وزارة الأوقاف، القاهرة- جمهورية مصر العربية، 1400هـ- 1980م.
([40]) انظر: الأشباه والنظائر (ص 84) للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ- 1990م.
([41]) انظر: الأشباه والنظائر (ص 88) للسيوطي.
([42]) التعريفات (ص 138).
([43]) انظر: معجم لغة الفقهاء (ص 284) لمحمد رواس قلعجي- حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1408هـ- 1988م.
([44]) انظر: معجم لغة الفقهاء (ص 171).
([45]) انظر: التعريفات الفقهية (ص 75) لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1424هـ- 2003م.
([46]) الموافقات (2/ 17- 23 ) للإمام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1417هـ- 1997م.
([47]) انظر: المصباح المنير (ر ش و).
([48]) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 221).
([49]) تفسير الطبري (10/ 318، 319).
([50]) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب كراهية الرشوة (3580)، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم (1337)، وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة (2313)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
([51]) أخرجه أحمد في المسند (22399)، والبيهقي في شعب الإيمان (5115) من حديث ثوبان رضي الله عنه.
([52]) العرف الشذي شرح سنن الترمذي (3/ 72، 73) للإمام محمد أنور شاه بن معظم الكشميري الهندي، تصحيح: الشيخ محمود شاكر، دار التراث العربي، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1425هـ- 2004م.
([53]) انظر: الدقيقة (5:15) من مقطع مرئي بعنوان (القرضاوي يؤيد مرسي ويفتي بجواز أخذ الرشوة الانتخابية)، منشور على موقع اليوتيوب، بتاريخ: 22/ 7/ 2012م.
([54]) انظر: تاج العروس (باب الجيم، فصل الحاء مع الواو).
([55]) انظر: الأشباه والنظائر (ص 84) للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ- 1990م.
([56]) الأشباه والنظائر (ص 73، 74) للإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ- 1999م.
([57]) انظر: الدقيقة (4:55) بالمقطع المرئي المنشور بعنوان (القرضاوي يؤيد مرسي ويفتي بجواز أخذ الرشوة الانتخابية).
([58]) انظر: الأشباه والنظائر (ص 88) للسيوطي.
([59]) المنثور في القواعد الفقهية (2/ 319) للإمام أبي عبدالله بدرالدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، 1405هـ- 1985م.
([60]) المبسوط (9/ 140) لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، 1414هـ- 1993م.
([61]) المهذب في فقه الإمام الشافعي (3/ 362) للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الكتب العلمية.
([62]) الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 298، 299).
([63]) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 79).
([64]) مجموع الفتاوى (32/ 236) للإمام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية، 1416هـ- 1995م.
([65]) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 74).
 العربية
العربية English
English French
French Deutsch
Deutsch Urdu
Urdu Pashto
Pashto Swahili
Swahili Hausa
Hausa