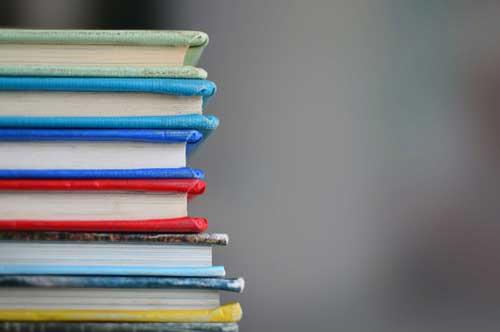حرص الإسلام على ترتيب شؤون الناس بما يحقِّق لهم المصلحةَ في العاجل والآجل، ويبتعد بهم عن كل ما يؤدي إلى الضرر والمفسدة؛ فأرشدهم إلى تحصيل أسباب القوة، وأمرهم بإتقان العمل، ونهاهم عن التسرع وعدم التَّروي في الأقوال والأعمال على غير علم وتَمَكُّنٍ وتَحَقُّقٍ، ودعاهم إلى ردِّ الأمور إلى أهل الخبرة ومراعاة التخصص؛ فهم أحق بها وأهلها؛ فقال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83].
ولا شكَّ أنه في أزمنة الفتن وحالات الحروب وأوقات الأزمات تشتد الحاجةُ إلى هذين الأمرين: الأول: استبيان الأمر والتحقُّق منه قبل الخوض فيه والتكلم عنه.
والثاني: رد الأمر لأهله الذين هم أعلم به.
أما الأمرُ الأول؛ فقد ورد به الأمرُ الإلهي، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]، ونطق به أيضًا البيانُ النبوي الذي لا ينطق عنه الهوى؛ وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة "صحيحه"؛ فعن أبي هُريْرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ».
وقد أورد الحافظ ابن كثير في كتابه في "الفتن والملاحم" إشارة نبوية، وأنه ستكون فتنٌ وقعُ اللسان فيها أشدُّ من وقعِ السيف؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ، قَتْلَاهَا فِي النَّارِ، اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ» رواه أبو داود.
قال العلماء: لأنه بالسيف يُقتل واحد، وباللسان يُقتل ألف واحد.
ولَمَّا كانت الشائعات تمثل خطرًا عظيمًا على المجتمعات؛ حيث يتم من خلالها بث أخبار غير صحيحة يترتب عليها ضرر للخاصة والعامة، أو إشاعة أخبار مغلوطة تُغذي الوهن والضعف في قلوب الناس، فلَمَّا كانت الشائعات كذلك حرص الإسلام على التحذير من نشرها وإذاعتها من أجل إحداث فوضى تؤدي إلى أضرار ومفاسد على المدى القريب والمدى البعيد.
وأما الأمر الثاني، وهو مراجعة أولي الأمر والعودة إلى أهل الحل والعقد -أي: حل الأمور وعقدها- فيما ينزل بالناس ويشغل بالَـهم؛ لأن هذا من باب وضع الأمر في محله؛ فهؤلاء هم الأقدر على تمحيص الأمور بعين الناقد، ومعالجة القضايا بحنكة القائد، وقد حرص الإسلام أيَّما حرص على مراعاة الاختصاص ورد الأمر إلى أهله، وتلك سمة فارقة اتَّسم بها الإسلام، وحثَّ عليها أتباعه منذ أول عهده؛ فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم حريصًا كل الحرص بأن يُوسِّد الأمر لأهله، بل جعل صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الساعة وأماراتها: إسناد الأمر إلى غير أهله.
ومما سبق؛ استنبط العلماء خطر خوض العامة وغير المتخصصين في السياسة وأمور الحرب؛ لأنهم إن شُغِلُوا بذلك أضاعوا أعمالهم وأمور معيشتهم، بل يقع الضرر الأكبر إذا ما وَقَفُوا على أسرارٍ سواءٌ كانت حقًّا أو باطلًا وتحدَّثوا بها، فيَقَعُ عليها المتربصون من الأعداء وأصحاب الأغراض، فيأخذونها مأخذ الجد مستفيدين منها من أجل إفساد البلاد وإهلاك العباد.
المراجع:
- "فتح الباري شرح صحيح البخاري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (ط. دار المعرفة، بيروت 1379هـ).
- "النهاية في الفتن والملاحم" للإمام ابن كثير تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز (ط. دار الجيل، بيروت لبنان 1408هـ-1988م).
- "تفسير المنار" للشيخ محمد رشيد رضا، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1990م.
- "خلق المسلم" للشيخ محمد الغزالي، ط. دار نهضة مصر، القاهرة، الطبعة الأولى.
- "التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج" للدكتور وهبة الزحيلي، ط. دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة الثانية 1418هـ).
 العربية
العربية English
English French
French Deutsch
Deutsch Urdu
Urdu Pashto
Pashto Swahili
Swahili Hausa
Hausa