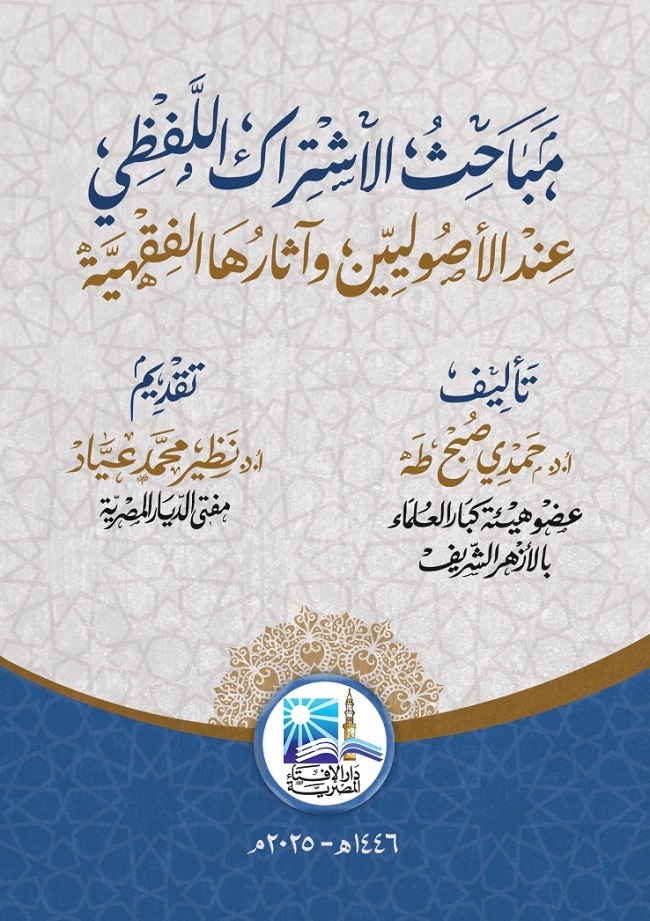الحمدُ لله ربِّ العالمين، وأُصلِّي وأُسلِّم على المبعوث رحمةً للعالمين؛ سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه.
أما بعد:
فالحديث عن العلاقة بين اللغة العربية وبين العلوم الإسلامية حديث ذو شجون، تتعدَّد اتجاهاتُه وتتنوع مساراتُه بتعدد العلوم الإسلامية.
والمُطالع لهذه المسارات يقف على عمق علاقة اللغة العربية وارتباطها بالعلوم الإسلامية، الأمر الذي يؤكد حاجة هذه العلوم إلى اللغة العربية، ومن ثم وجدنا العلماء في كلِّ تخصص يدعون إلى تعلمها والإحاطة بها، وجعلوا ذلك من أولويات كل علم، حرصًا منهم على إثبات الصلات الوثيقة بين علومهم وبين اللغة العربية، وأوجبوا تعلمها قبل كل شيء؛ يقول الزمخشري عن أصحاب العلوم المختلفة وحاجتهم إلى اللغة: «وذلك أنهم لا يجدون علمًا من العلوم الإسلامية؛ فقهها وكلامها وعلمي تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بَيِّن لا يُدفع ومكشوف لا يُتَقَنّع» ([1]).
وهو عين ما أكده الفيروزآبادي بقوله: «إن بيان الشريعة لمَّا كان مصدره عن لسان العرب, وكان العمل بموجبه لا يصح إلا بإحكام العلم بمقدمته وجب على روّام العلم وطلاب الأثر أن يجعلوا أعظم اجتهادهم واعتمادهم, وأن يصرفوا جلَّ عنايتهم في ارتيادهم إلى علم اللغة والمعرفة بوجوهها والوقوف على مُثُلها ورسومها» ([2]).
ونصَّ عليه الإمامُ الشاطبي عندما أشار إلى الاقتران بين علم اللغة وعلم الشريعة حيث ذكر أن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهما حقَّ الفهم إلا مَن فهم اللغةَ العربية حقَّ الفهم([3]).
والواقع أن اهتمام العلماء -في شتَّى العلوم الإسلامية- باللغة العربية وحرصهم على إتقانها مردّه إلى أصول الشرع الحنف، والتي وردت فيها نصوصٌ تُوجِّه إلى هذا الاهتمام وذلك الحرص، ويكفي تأكيدًا على ذلك أن الله - سبحانه وتعالى – قد بين أن القرآن الكريم نزل بلسان القوم الذين نزل عليهم، وهو اللسان العربي؛ ليتدبروه وليعقلوه وليفهموا مردَّه ليعملوا بأحكامه، فقال تعالى -: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (سورة يوسف – الآية 2).
وقال تعالى: {وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ} (سورة الشعراء من الآية 192 – 195).
وقال تعالى مخاطبًا نبيه ﷺ: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (سورة النحل – الآية 44).
فالمطالع لهذه الآيات يُدرك أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم عربيًّا، بمعنى أنه «لا عجمة فيه وهو جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب» ([4]).
فقد نزل القرآن الكريم عربيًا، «والمخاطبون به قوم عرب أُولو بيانٍ فاضل وفهم بارع، أنزله – جلَّ ذكره – بلسانهم وصيغة كلامهم الذي نشئوا عليه وجُبلوا على النطق به، فتدربوا به، يعرفون وجوه خطابه ويفهمون فنون نظامه» ([5]).
أما عن سيدنا محمد ﷺ: فقد كان ﷺ عربيًّا، بل هو أفصح العرب لسانًا وأبلغهم بيانًا، وعنده حطت البلاغة بعلومها، ولم لا وقد أُعطي جوامع الكلم ﷺ، فعرف بأنه خير من نطق بلغة الضاد، كذلك كان القوم الذين بُعث فيهم وأُرسل إليهم عربًا، فكان خطابه لهم على حسب ما ألِفوه في لسانهم، فليس فيما دعاهم إليه «شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على ما اعتادوه» ([6]).
ومن ثم اتفقت كلمة العلماء أن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها للمسلم ضرورة حياتية وفريضة دينية؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
فإذا كان القرآن والسُّنة اللذان هما أصل الدين منزلين باللغة العربية كان علمها والإلمام بها ضروريًّا لفهم نصوص هذين الأصلين، وأن مَن أراد فهمهما فمِن جهة لسان العرب يُفهمان ولا سبيل إلى تطلب فهمهما من غير هذه الجهة([7]).
كذلك فقد تعددت الأقوال الواردة عن سلف الأُمة والتي تؤكد على أهمية اللغة العربية وضرورة العناية بها وإتقانها، خصوصًا للمشتغلين بالعلوم الشرعية، باعتبارها شرط رئيس لفهم مراد الله تعالى ومعرفة أحكامه.
فنُقل عن سيدنا عبد الله بن مسعود ﭬ قوله: «جَوِّدوا القرآنَ وزيِّنوه بالأصوات وأعربوه فإنه عربي، والله يحب أن يعرب» ([8]).
ونصَّ الإمامُ الشافعيُّ ﭬ على وجوب تعلمها فقال: «يجب على كلِّ مسلم أن يتعلَّم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه» ([9]).
فكل هذه الأقوال وغيرها تؤكد على فضل العربية ووجوب تعلمها وإتقانها قبل الاشتغال بالعلوم الشرعية.
يقول الإمام الشافعي ﭬ: «فإنما خاطب الله بكتابه العربَ بلسانها، على ما تَعْرِف مِن معانيها، وكان مما تعرف من معانيها: اتساعُ لسانها، وأنَّ فِطْرَتَه أنْ يخاطِبَ بالشيء منه عامًّا، ظاهِرًا، يُراد به العام، الظاهر، ويُسْتغنى بأوَّل هذا منه عن آخِرِه. وعاماً ظاهراً يراد به العام، ويَدْخُلُه الخاصُّ، فيُسْتَدلُّ على هذا ببَعْض ما خوطِبَ به فيه؛ وعاماً ظاهراً، يُراد به الخاص. وظاهراً يُعْرَف في سِياقه أنَّه يُراد به غيرُ ظاهره. فكلُّ هذا موجود عِلْمُه في أول الكلام، أوْ وَسَطِهِ، أو آخِرَه. وتَبْتَدِئ الشيءَ من كلامها يُبَيِّنُ أوَّلُ لفظها فيه عن آخره. وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظِها منه عن أوَّلِهِ. وتكلَّمُ بالشيء تُعَرِّفُه بالمعنى، دون الإيضاح باللفظ، كما تعرِّف الإشارةُ، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها، لانفراد أهل علمها به، دون أهل جَهَالتها. وتسمِّي الشيءَ الواحد بالأسماء الكثيرة، وتُسمي بالاسم الواحد المعانيَ الكثيرة. وكانت هذه الوجوه التي وصفْتُ اجتماعَها في معرفة أهل العلم منها به - وإن اختلفت أسباب معرفتها -: مَعْرِفةً واضحة عندها، ومستَنكَراً عند غيرها، ممن جَهِل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتابُ، وجاءت السنة، فتكلَّف القولَ في علمِها تكلُّفَ ما يَجْهَلُ بعضَه. ومن تكَلَّفَ ما جهِل، وما لم تُثْبِتْه معرفته: كانت موافقته للصواب - إنْ وافقه من حيث لا يعرفه - غيرَ مَحْمُودة، والله أعلم؛ وكان بِخَطَئِه غيرَ مَعذورٍ، وإذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بيْن الخطأ والصواب فيه»([10]).
وعلم أصول الفقه أحد هذه العلوم الذي بينه وبين اللغة العربية صلة وثيقة؛ خصوصًا وأنه يُنظر إليه على أنه هو علم أدلة الفقه، وأدلة الفقه الكتاب والسنة، وهما عربيات قولا بلسان عربي مبين، فإذا لم يكن الأصولي عالمًا باللغة وأحوالها عائقًا بأبعادها ومدركًا لموضوعاتها، وعالمًا بأسرارها، محيطًا بقوانينها؛ تعذر عليه النظر السليم والحكم المستقيم، ومن ثم بعد عليه النظر الصحيح، ومن ثم «اتعذر استنباط الأحكام الشرعية منها، ولذلك صار النحو شرطًا في رتبة الاجتهاد»([11]).
وهذا ما نص عليه علماء الأصول؛ فها هو الإمام الغزالي يقول: «ولا بد من علم اللغة فإن مآخذ الشرع الفاظ عربية وينبغي أن يستقل بفهم كلام العرب ولا يكفيه الرجوع إلى الكتب فإنها لا تدل إلا على معاني الالفاظ فأما المعاني المفهومة من سياقها وترتيبها لا تفهم إلا يستقل بها والتعمق في غرائب اللغة لا يشترط ولا بد من علم النحو فمنه يثور معظم إشكالات القرآن»([12]).
ويقول في موضع آخر: «فعلم اللغة والنحو، أعني القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه. والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه»([13]).
ولقد أكد هذه الحقيقة الإمام تاج الدين السبكي وهو يتحدث عن المجتهد وشروطه قائلًا: «واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء:
أحدها: التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه وما يحتاج إليه من العلوم العقلية في صيانة الذهن عن الخطأ بحيث تصير هذه العلوم ملكة الشخص فإذ ذاك يثق بفهمه لدلالات الألفاظ من حيث هي هي وتحريره تصحيح الأدلة من فاسدها والذي نشير إليه من العربية وأصول الفقه كانت الصحابة أعلم به منا من غير تعلم وغاية المتعلم منا أن يصل إلى بعض فهمهم وقد يخطئ وقد يصيب»([14]).
ويؤكد على ذلك ابن خلدون فيقول في مقدمته ما نصه: «فلا بدّ من معرفة العلوم المتعلّقة بهذا اللّسان لمن أراد علم الشّريعة. وتتفاوت في التّأكيد بتفاوت مراتبها في التّوفية بمقصود الكلام حسبما يتبيّن في الكلام عليها فنّا فنّا والّذي يتحصّل أنّ الأهمّ المقدّم منها هو النّحو إذ به تتبيّن أصول المقاصد بالدّلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر ولولاه لجهل أصل الإفادة»([15]).
ولهذا وجدنا الإمام الغزالي يذهب إلى أن المطلوب من الفقيه والأصولي معرفة «القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه»([16]).
لكل ما سبق كانت الدعوة إلى تعلم اللغة العربية والعناية بها مبكرة جدًا في التاريخ الإسلامي؛ إذ كان يُعتقد أن دراستها عبادة وكلما كان المرء على علم بها ودراية كان أكثر فهما واستنباطا لأحكام الشريعة.
ولهذا فالعلاقة بين علوم اللغة وأصول الفقه علاقة قديمة قدم علم أصول الفقه نفسه. وتزداد هذه العلاقة وضوحًا إذا علمنا ببيان أن «الشريعة عربية ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة»([17]).
وهذا ما أكد عليه الإمام الشاطبي فهو يذهب إلى «أن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم؛ لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا؛ فهو متوسط في فهم الشريعة والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولا»([18]).
فلا يمكن الوقوف على مراد الله ورسوله إلا بمعرفة اللغة العربية، والوقوف على دلالات الألفاظ ومقاصدها لا يتأتى إلا بها.
ولهذا نجد الإمام الشاطبي يذهب إلى أبعد من ذلك، عندما يجعل أن من بين شروط المجتهد أن يكون مجتهدا في العربية؛ إذ يقول: «وأما الثاني من المطالب: وهو فرضُ علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه، فإن كان ثُمَّ عِلم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه، فهو لا بد مضطر إليه؛ لأنه إذا فرض كذلك لم يُمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه، فلا بد من تحصيله على تمامه، وهو ظاهر، إلا أن هذا العلم مبهم في الجملة فيُسأل عن تعيينه، والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية»([19]).
ويقول ابن قتيبة: «وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره، واتسع علمه وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب»([20]).
ويقول ابن جني: «وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها، فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة»([21]).
وما ذكره ابن جني هو ما انتهى إليه الشيخ عبد القادر بدران الدمشقي حيث قال: «اعلم أن هذه التقاسيم - أي تقاسيم الكلام والأسماء هي المدخل في أصول الفقه من جهة أنه أحد مفردات مادته وهي الكلام والعربية، وتصور الأحكام الشرعية، فأصول الفقه متوقفة على معرفة اللغة لورود الكتاب والسنة بهما، اللذين هما أصول الفقه وأدلته، فمن لم يعرف اللغة لا يمكنه استخراج الأحكام من الكتاب والسنة»([22]).
بل يمكن القول بأن العلاقة بين علوم اللغة وعلم أصول الفقه تزداد من خلال النظرة إلى بعض الأصوليين، حيث ينظر إليهم على أنهم من أساطين اللغة وأربابها، وأبرز من يلوح في الأفق في هذا الجانب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الذي كان نادرة زمانه في هذا الجانب حتى قال عنه عبد الملك بن هشام النحوي صاحب السيرة: «طالت مجالستنا للشافعي، فما سمعت منه لحنة قط ولا كلمة غيرها أحسن منها»([23])، وقال أيضًا: «الشافعي كلامه لغة يحتج بها» ([24]).
فالعلاقة بينهما بلغت حدًا من التلاحم والتمازج، الأمر الذي «حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة»([25]).
فبين علوم اللغة وعلم أصول الفقه صلة قوية، يتضح ذلك من خلال مباحث الألفاظ والقياس والعام والخاص والمطلق والمقيد.. إلخ.
ويقول الإمام الزمخشري موضحًا طلب العلاقة بين علم الأصول وعلوم اللغة قائلا: «ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على علم الإعراب، وذلك أنهم لا يجدون أي: العلماء علمًا من العلوم الإسلامية إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع»([26]).
فالعلاقة بينهما قوية، خصوصًا وأن اللغة أحد العلوم المهمة التي يستمد منها علم أصول الفقه؛ بل إن معظم المباحث الأصولية مباحث لغوية، يدل على ذلك ما قام به علماء الأصول؛ فقد لوحظ عليهم التطرق إلى مباحث لغوية صرفة، وإطالة النفس في بحثها وتحريرها ، وإنما هي في حقيقة الأمر من جنس علوم العربية وصلبها، وقد تناولها بالبحث والدراسة عامة علماء اللغة على غرار مباحث اللغات أو مبادئ اللغات، وتوسعوا فيها توسعًا كبيرًا مما حدا بجمهرة من علماء الأصول على انتقادهم بناء على أنها قتلت بحثًا في علوم أخرى، وعليه فلا داعي إليها في علم الأصول، ثم لأنها مباحث لا تمت إلى القواعد الأصولية بصلة وثيقة»([27]).
وهذا ما يؤكده العلامة المازري حيث يقول: «مع أن العلم بأنه لا تمس الحاجة إليه في النظر في الأصوليات ولا يستعمل قانونًا كليًا في شيء من الاستدلالات»([28])، ولا بأس من الاستدلال بها فيما دعت إليه الحاجة الأصولية ولكن بمقدار «النظر في حكم حرف أو لفظة فإنما يحتاج إليها في الفقهيات في مسألة أو مسألتين، فلا معنى لإدخالها هنا؛ لأنها لا تكون كالقانون الكلي»([29])
كل هذا يؤكد مدى العلاقة بين علوم اللغة وعلم أصول الفقه وأن مظاهر تأثير اللغة العربية على علم أصول الفقه كبير يمكن تلخيصه فيما يأتي:
فيما يتعلق بالألفاظ ودلالاتها تكلم الأصوليون عن ما يسمى بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام([30])؛ يقول الإمام الغزالي: «ويتضح المقصود منه - أي من الفصل الأول - في دلالة الألفاظ على المعاني، بتقسيمات: التقسيم الأول: إن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجه، وهي المطابقة والتضمن والالتزام، فإن لفظ البيت دل على معنى البيت بطريق المطابقة، ويدل على السقف وحده بطريق التضمن، فإن البيت يتضمن السقف؛ لأن البيت عبارة عن السقف والحيطان»([31]).
وناقش الأصوليون القضايا اللغوية ذات العلاقة بالألفاظ ودلالاتها، فتكلموا عن التبيان، وألفاظه والمترادف والمشترك والمجمل والظاهر والمئول، ثم تكلموا عن مدلول اللفظ إما معنى أو لفظا مفردًا أو مركبا، وقسموا المركب إلى استفهام وأمر والتماس، وتكلموا عن تقاسيم الأسماء فهي: إما وضعية أو عرفية أو شرعية أو مجاز مطلق، وناقشوا هذه الألفاظ التي استفيدت منها المعاني الشرعية، هل خرج بها الشارع عن وضع أهل اللغة باستعمالها في غير موضوعهم؟
وفي معرض حديث الأصوليين عن الألفاظ ودلالاتها وقفوا عند الكلام ودرسوا معناه عندهم؛ حيث ذكروا فصلا خاصا عن الكلام، فقسموه إلى مفيد وغير مفيد، والذي يقصده الأصوليون هو الكلام المفيد تمامًا كما فعل أهل العربية، وهذا الكلام المفيد عند الأصوليين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي النص والظاهر والمجمل.
ويظهر التداخل بين اللغة والأصول في مناقشة الأصوليين للعموم والخصوص، فيقول الإمام الشافعي رادا على أحد المعترضين عليه: «قلتُ له: لسان العرب واسع، وقد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص»([32]).
وتحدث الأصوليون عن اللفظ:
باعتبار وضعه؛ فقسموه إلى ظاهر، ونص، ومفسر، ومحكم وخفي، ومشكل، ومجمل ومتشابه.
باعتبار كيفية دلالته على معناه؛ فقسموه إلى دال بالعبارة، ودال بالإشارة، ودال بالفحوى، ودال بالاقتضاء.
وتحدثوا عن تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب، كما تحدثوا عن الاشتقاق والترادف والمشترك، وعن دلالات المعاني كما تحدثوا عن الأمر والنهي والاستثناء.
ومما يدخل في هذا المجال أيضًا مباحث الحقيقة والمجاز التي أوردها الأصوليون في كتبهم، وكلُّ ما تقدم جعل الأصوليين يذكرون من ضمن شروط الاجتهاد الإلمام بالعربية([33]).
ولم يقتصر الأصوليون على ذلك؛ بل تناولوا أيضًا نقل الألفاظ العربية بالمعنى، وهذه مسألة أساسية عند الفقيه والأصولي، وإنما نقصد بالألفاظ العربية، الألفاظ التي جاء بها خطاب الشارع، ولا شك أن تغيير الألفاظ وتبديلها قد يؤدي إلى تغيير معانيها ومقاصدها، مما كان ذلك محط نقد الرجال وتجريحهم والكلام في ضبطهم، ولهذا انعقد الإجماع بين العلماء على أن الراوي الذي يروي بالمعنى لا تقبل روايته إلَّا إذا كان عالما بتغيير المعاني وما تحيله، والعلم بتغيير المعاني هو العلم بألفاظ الحديث ولغته ([34]).
يقول ابن الصلاح: «أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يُحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطًا لما يرويه. وتفصيله: أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلا، سالمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظًا غير مغفل، حافظًا إن حدث من حفظه، ضابطًا لكتابه إن حدث كتابه. وإن كان يُحدث من بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالمًا بما يحيل المعاني والله أعلم» ([35]).
والأصوليون لم يغفلوا هذا المبحث لتعلقه أيضًا بمجالهم، حيث ينظرون في الألفاظ ومعانيها وأوجه دلالتها المختلفة، وأي تغيير وتبديل في اللفظ سيؤدي إلى تغيير دلالته فحكم الأصوليون بالحرمة على فعل ذلك في غياب الشروط اللازمة لهذا النقل ([36])؛ يقول الإمام الغزالي: «نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ» ([37]).
فكل هذا يوضح العلاقة بين علم أصول الفقه وعلوم اللغة، وتزداد هذه العلاقة أيضًا وضوحًا من خلال الوقوف على أثر أصول الفقه في أصول النحو ؛ إذ من خلال ذلك نوضح أن العلاقة بينهما لم تكن قاصرة أو محصورة في الاستمداد من العربية وحسب؛ بل تعدى ذلك بأن كان التأثير بينهما متبادلا، وهذا ما وضحه الإمام السبكي بقوله: «إن الأصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون، فإن كلام العرب متسع جدًا، والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصول واستقراء زائد على استقراء اللغوي، مثاله : دلالة صيغة (افعل) على الوجوب (ولا تفعل) على التحريم وكون (كل وإخوتها للعموم) وما أشبه ذلك .... لو فتشت كتب اللغة لم تجد فيها شفاء في ذلك ولا تعرضًا لما ذكره الأصوليون، وكذلك كتب النحو إذ لو طلبت معنى الاستثناء وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم، ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون وأخذوها باستقراء خاص من كلام العرب، وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو، فهذا ونحوه مما تكفلت به أصول الفقه، ولا ينكر أن له استمدادًا من تلك العلوم، ولكن تلك الأشياء التي استمدها منها لم تذكر فيه بالذات ؛ بل بالعرض » ([38]).
فاللغة العربية مورد رئيس لعلم أصول الفقه؛ ذلك أنه مستمد من: «علم الكلام والعربية والأحكام الشرعية.
أما علم الكلام، فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعا على معرفة الله تعالى وصفاته، وصدق رسوله فيما جاء به، وغير ذلك مما لا يعرف في غير علم الكلام.
وأما علم العربية، فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة: الحقيقة، والمجاز، والعموم، والخصوص، والإطلاق، والتقييد، والحذف، والإضمار، والمنطوق، والمفهوم، والاقتضاء، والإشارة، والتنبيه، والإيماء، وغيره مما لا يعرف في غير علم العربية.
وأما الأحكام الشرعية، فمن جهة أن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون عالما بحقائق الأحكام ليتصور القصد إلى إثباتها ونفيها، وأن يتمكن بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة الشواهد، ويتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال» ([39]).
فاللغة واحدة من الأسس التي يقوم عليها علم الأصول؛ فقد أسس هذا العلم على منطق اللغة العربية وهديها، فكانت هي السبيل المؤدي إلى استنباط الحكم من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا ما نص عليه العلامة ابن خلدون بقوله: «(واعلم) أنّ هذا الفنّ من الفنون المستحدثة في الملّة وكان السّلف في غنية عنه بما أنّ استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد ممّا عندهم من الملكة اللّسانيّة. وأمّا القوانين الّتي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أخذ معظمها. وأمّا الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النّظر فيها لقرب العصر وممارسة النّقلة وخبرتهم بهم. فلمّا انقرض السّلف وذهب الصّدر الأوّل وانقلبت العلوم كلّها صناعة كما قرّرناه من قبل احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلّة فكتبوها فنا قائما برأسه سمّوه أصول الفقه» ([40]).
لقد عني الأصوليون بمسألة المشترك اللفظي؛ وذلك لأهميته في الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح؛ وهو ما حرصت عليه هذه الدراسة الماتعة، والتي قام بها أستاذنا الدكتور حمدي صبح حفظه الله، أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو هيئة كبار العلماء، والذي أوقف دراسته هذه على المشترك اللفظي والذي اشتد الخلاف حال وقوعه واستعماله وهو ما ترتب عليه اختلاف في الأحكام الشرعية.
إذ من المعلوم أن دلالة النص على الحكم الشرعي قد تكون قطعية، كدلالة كل عدد على معناه الخاص في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة} (النور: 4).
ومثل دلالة قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (المائدة: 6)، على وجوب أصل مسح الرأس في الوضوء، وهذا هو الغالب في الآيات القرآنية.
بيد أن هذه الدلالة قد تكون ظنية أي على سبيل الاحتمال الراجح، كدلالة قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، على مقدار ما يمسح من الرأس في الوضوء، أهو جميع الرأس أم بعضها؟
وكدلالة لفظ «القرء» على الحيض وهو ما أخذ به الحنفية، أو على الطهر وهو مذهب غيرهم، وذلك من قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء} (البقرة: 228)، لأن لفظ القرء مشترك بين المعنيين ([41]).
ونتيجة لهذا وغيره اتجه الأصوليون إلى تقسيم الدلالات باعتبارات كثيرة، ووضعوا لكل نوع منها مصطلحًا خاصًا؛ لأن ذلك يخلص بهم في نهاية الأمر إلى استثمار الأحكام الشرعية من النصوص على أساس من النتائج التي توصلوا إليها في دراسة المعنى اللغوي([42]).
وكل هذا دفعًا للإيهام، ومنعًا من الخلاف ووصولا إلى المراد وهذا ما ينبه عليه الإمام الغزالي بقوله: «وإنما منشأ هذا الغلط الذهول عن معرفة الاسم المشترك على ما سنذكره فإن من يحد العين بأنه العضو المدرك للألوان بالرؤية لم يخالف من حده بأنه الجوهر المعدني الذي هو أشرف النقود بل حد هذا أمرا مباينا لحقيقة الأمر الآخر، وإنما اشتركا في اسم العين فافهم هذا فإنه قانون كثير النفع» ([43]).
ولهذا فإن علماء الأصول استوعبوا هذه القضية في أصلها – أعني المشترك اللفظي -، وقرروا بأنه متى كان الاسم مشتركًا بين أكثر من معنى، وجب أن نطلب له معان على حسب عدد الأسماء المشتركة؛ فإن كان الاشتراك واقعا بين اسمين، وجب إيجاد معنيين مختلفين، وإن كان بين ثلاثة وجب إيجاد ثلاثة معان، وهكذا، كل هذا من أجل ضبط هذه المشتركات لئلا تقع الأسماء على غير مراداتها، قال الإمام الغزالي: «فإذا ذكر لك اسم وطلب منك حده فانظر فإن كان مشتركا فاطلب عدة المعاني التي فيها الاشتراك، فإن كانت ثلاثة فاطلب لها ثلاثة حدود، فإن الحقائق إذا اختلفت فلا بد من اختلاف الحدود»([44]).
ويقول أيضًا: «فاعلم أن الاختلاف في الحد يتصور في موضعين أحدهما: أن يكون اللفظ في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﷺ أو قول إمام من الأئمة يقصد الاطلاع على مراده به فيكون ذلك اللفظ مشتركا فيقع النزاع في مراده به فيكون قد وجد التوارد على القائل والتباين بعد التوارد فالخلاف تباين بعد التوارد»([45]).
فكل من خاض بلفظ مشترك، لزمه بيان مراده من اللفظ عند إيراده، ووضع علامات توضح هذا المراد؛ لئلا يختلط بغيره، قال القرافي: «واللفظ إذا كان مشتركا بين معان مختلفة، وحددنا بعض تلك المعاني، لا يرد علينا غيره من تلك المعاني؛ نقضًا ولا سؤالا»([46])، وقال: «إذا كان اللفظ مشتركا، وكنا متعرضين بالحد لأحد مسميات المشترك، لا يرد علينا المسمى الآخر، بل لكل مسمى حد يليق به»([47]).
ولهذا قال علماء الأصول: «لأن الكلام وضع للإفهام، والمشترك إلى الإبهام أقرب منه إلى الإفهام»([48])، وأبان الإمام الغزالي عن هذا فقال: «وإنما منشأ الإشكال التخاوض في هذه الأمور، دون التوافق على حدود معلومة لمقاصد العبارات؛ فيطلق المطلق عبارة لمعنى يقصده، والخصم يفهم منه معنى آخر يستبد هو بالتعبير به عنه، فيصير به النزاع ناشبًا قائمًا: لا ينفصل أبد الدهر»([49]).
ومن هنا حرص العلماء على وضع المصطلحات الخاصة بالعلوم والفنون منعًا للتداخل بينها، وهو ما أشار إليه أحد الباحثين بقوله: «الأصل في كل اللغات، أن يُعبِّر اللفظ الواحد عن المعنى الواحد»([50])، ومن هنا عد علماء الأصول «الاشتراك اللفظي» من أسباب الإجمال، التي يتوقف فيها حتى يظهر معناها لذا وضعوا قاعدة: «كل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشترك؛ فالمجمل أعم من المشترك»([51]).
حتى إن الصحابة ﭫ التبس عليهم الفهم أكثر من مرة بسبب الاشتراك اللفظي، يدل على ذلك تفسيرهم للظلم الوارد في قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82]، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﭬ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ، أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}»([52]).
وكذلك في تحديد معنى: «الخيط الأبيض والخيط الأسود» في الصيام، فعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﭬ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187] عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ، فَلاَ يَسْتَبِينُ لِي، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ» ([53]).
قال القاضي عياض: «وفيه وجوب التوقف عند الألفاظ المشتركة، وطلب البيان فيها، وأنها لا تحمل على أظهر وجوهها، وأكثر استعمالاتها، إلا عند عدم البيان فيها، وقد كان البيان عتيداً بوجود النبي ﷺ»([54]).
ومن ثم فإن معرفة قواعد العربية وأوجه دلالاتها هي الطريق الأمثل لفهم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على وجهتهما الصحيحة، يقول الإمام الشافعي: «ومن جماع علم كتاب الله: العلمُ بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب»([55])، ويقول أيضًا: «لأنه لا يعلم مِن إيضاح جُمَل عِلْم الكتاب أحد، جهِل سَعَة لسان العرب، وكثرةَ وجوهه، وجِماعَ معانيه، وتفرقَها. ومن علِمه انتفَتْ عنه الشُّبَه التي دخلَتْ على من جهِل لسانَها»([56]).
وقال بدر الدين الزركشي: «وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه»([57]).
فكل هذا يؤكد على أن دور اللغة وعلاقتها بعلم أصول الفقه وما يمكن أن تسهم به في بيان الحكم الشرعي من ناحية، وإزالة اللبس ورفع الإيهام وإبانة الغامض من ناحية ثانية، وهو ما يكشف عن أهمية هذا العمل الذي نقدم له، والذي جاء بعنوان: «الاشتراك اللفظي عند الأصوليين وآثارها الفقهية»، وهو في أصله رسالة الماجستير لأستاذنا حفظه الله، والتي جاءت في تمهيد وخمسة أبواب يتخللها فصول جاءت على النحو التالي:
الباب الأول: تعرض فيه لتعريف المشترك اللفظي والمشترك المعنوي والتمييز بينهما.
والباب الثاني: تعرض فيه لوضع المشترك.
وأما الباب الثالث: فتحدث فيه عن استعمال المشترك.
والباب الرابع: تعرض فيه لحمل المشترك.
وختم بالباب الخامس: الذي خصصه للآثار الفقهية لمباحث الاشتراك.
وأهم ما يلاحظ هو هذا الترتيب المنطقي، والعرض المنهجي الذي اتسم به هذا العمل، والمناقشة العميقة والاستنباط والعرض الدقيق، والترجيح المؤسس على حجج وبراهين، ولا غرابة في ذلك؛ فقد صدرت عن عالم معروف وشيخ كبير عرف بفضله وسعة علمه وغزارة معارفه؛ ألله أسأل له العناية والرعاية والتوفيق والهداية.
ولكل ما سبق؛ فقد رأت دار الإفتاء المصرية أن تقوم بنشر هذا العمل قيامًا بالواجب، وأداء للأمانة، وخدمة لطلاب العلم والدارسين؛ فإن كنا قد أصبنا فذلك من فضل الله علينا، وإن كانت الأخرى فذلك من أنفسنا والشيطان، والله عز وجل ورسوله ﷺ من براء، قال تعالى: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} (النساء: 79).
والله أسأل أن يجعل هذا العمل في ميزان كاتبه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أ.د. نظير محمد عياد
مفتي جمهورية مصر العربية
رئيس الأمانة العامة لهيئة ودور الإفتاء في العالم
([1]) المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري، تحقيق: د. علي أبو ملحم، صـ 18، مكتبة الهلال، بيروت، ط:1، 1993م.
([2]) القاموس المحيط، الفيروزآبادى، صـ18، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت، ط:8، 1426 هـ - 2005 م.
([3]) الموافقات، الشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 5/53، دار ابن عفان، ط:1، 1417هـ/ 1997م.
([4]) الاعتصام، الشاطبي، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، صـ804، دار ابن عفان- السعودية، ط:1، 1412هـ - 1992م.
([5]) تهذيب اللغة، الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، 1/5، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط:1، 2001م.
([6]) الاعتصام، الشاطبي، صـ805.
([7]) الموافقات، الشاطبي، 2/ 102.
([8]) المرجع السابق، 1/ 16.
([9]) إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، 2/167.
([10]) الرسالة: الإمام الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، صـ50، مكتبه الحلبي، مصر، ط:1، 1358هـ/1940م.
([11]) الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، الإمام الإسنوي، تحقيق؛ د، محمد حسن عواد، ﺻ42، دار عمار للنشر والتوزيع.
([12]) المنخول من تعليقات الأصول، الإمام الغزالي، حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتو، صـ572، ط:3، دار الفكر العربي- بيروت، ط:3، 1419 هـ - 1998 م.
([13]) المستصفى، الإمام الغزالي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، صـ344، دار الكتب العلمية - بيروت، 1413هـ، 1993م.
([14]) الإبهاج في شرح المنهاج، الإمام تقي الدين السبكي، 1/8، دار الكتب العلمية- بيروت، 1416هـ، 1995م.
([15]) مقدمة ابن خلدون، تحقيق: خليل شحادة، صـ753، دار الفكر-بيروت، ط:2، 1408هـ- 1988م.
([16]) المستصفى، الإمام الغزالي، صـ344.
([17]) البرهان في أصول الفقه، الإمام الجويني، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية- بيروت، ط:1، 1418هـ - 1997م.
([18]) الموافقات، الإمام الشاطبي، 5/53.
([19]) الموافقات، الإمام الشاطبي، 5/52.
([20]) تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، صـ17، دار الكتب العلمية- بيروت.
([21]) الخصائص، لابن جني، 3/248، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط:4.
([22]) ينظر: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر، عبد القادر بدران الدمشقي، ٢ / ٥، دار الحديث بيروت، ط:1، 1412هـ- 1991م.
([23]) مناقب الشافعي للبيهقي، تحقيق: السيد أحمد صقر، 2/43، مكتبة دار التراث – القاهرة، ط:1، ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠م.
([24]) معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ياقوت الحموي، تحقيق: إحسان عباس، 6/ 2402، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط:1، 1414 هـ - 1993 م
([25]) المستصفى، الإمام الغزالي، صـ9.
([26]) المفصل في صنعة الإعراب، الإمام الزمخشري، تحقيق، د. علي بو ملحم، صـ18، ط:1، دار الهلال- بيروت، 1993م، بتصرف.
([27]) حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية - د. حسن يشو، صـ374، إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -قطر، ط:1، 1434هـ، 2013م.
([28]) إيضاح المحصول، الإمام المازري، تحقيق: د. عمار الطالبي، صـ147، ط ١، دار الغرب الإسلامي، ۲۰۰۱م.
([29]) إيضاح المحصول، صـ159.
([30]) الابتهاج في شرح المنهاج، 1/218.
([31]) المستصفى: الإمام الغزالي، 1/25.
([32]) جامع العلم الإمام الشافعي، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، صـ۱۹، دار الكتب العلمية، ط:1، وينظر: العلاقة بين علم أصول الفقه وعلم أصول النحو، د. عراك جبر شلال، صـ ۳۰۳، ملحق مجلة كلية الشريعة، العدد الثالث.
([33]) ينظر: العلاقة بين علم أصول الفقه وعلم أصول النحو، د. عراك جبر شلال، صـ۳۰۱، ۳۰۲، وينظر: علم أصول الفقه وعلاقته بالدرس اللغوي، د. صلاح علي مضعن، م.م. عماد حميد صـ۲۳۰-۲۳۲، مؤتمر علم أصول الفقه وصلته بالعلوم الأخرى ملحق كلية الشريعة- العدد الثالث.
([34]) ينظر: علم أصول الفقه وعلاقته بالدرس اللغوي، فؤاد بو فجيج، صـ۱۷.
([35]) مقدمة ابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، صـ105، دار الفكر- سوريا، دار الفكر المعاصر – بيروت، 1406هـ - 1986م.
([36]) ينظر: العلاقة بين علم أصول الفقه وعلم أصول النحو، د. عراك جبر شلال، صـ۳03.
([37]) المستصفى: الإمام الغزالي، 1/168.
([38]) الإبهاج في شرح المنهاج، 1/807- بتصرف.
([39]) الإحكام في أصول الأحكام، الإمام الآمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، 1/ 7، 8، المكتب الإسلامي، بيروت.
([40]) مقدمة ابن خلدون، صـ 575- 576.
([41]) ينظر: بحث المشترك اللفظي عند الأصوليين وأثر ذلك في الفقه الإسلامي، د. شعبان محمد إسماعيل، صـ135.
([42]) ينظر: دراسة المعنى عند الأصوليين للدكتور طاهر سليمان حموده، صـ11- 12.
([43]) المستصفى: الإمام الغزالي، صـ18.
([44]) المستصفى: الإمام الغزالي، صـ19.
([45]) المستصفى: الإمام الغزالي، صـ20.
([46]) الفروق: الإمام القرافي، 2/58، عالم الكتب.
([47]) نفائس الأصول شرح المحصول، الإمام القرافي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، 1/326، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط:1، 1416هـ، 1995م.
([48]) البحر المحيط: الإمام الزركشي، 2/381، دار الكتبي، ط:1، 1414هـ، 1994م.
([49]) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: الإمام الغزالي، تحقيق: د. حمد الكبيسي، صـ588، 589، مطبعة الإرشاد- بغداد، 1390هـ، 1971م.
([50]) دلالة الألفاظ، د. إبراهيم أنيس، صـ212، مكتبة الأنجلو المصرية، ط:3، 1976م.
([51]) ينظر: نفائس الأصول: الإمام القرافي، 5/2194.
([52]) صحيح البخاري، كتاب: تفسير القرآن، باب: {لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]، 6/114، رقم: 4776، صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: صدق الإيمان وإخلاصه، 1/114، رقم 124.
([53]) صحيح البخاري، كتاب: الصوم، باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، 3/28، رقم: 1916، صحيح مسلم، كتاب: الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك، 2/766، رقم 1090.
([54]) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، القاضي عياض، تحقيق: الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، 4/25، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط:1، 1419 هـ - 1998 م.
([55]) الرسالة: الإمام الشافعي، صـ34.
([56]) الرسالة: الإمام الشافعي، صـ47.
([57]) البرهان في علوم القرآن: الإمام الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 2/166، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، ط:1، 1376 هـ - 1957 م.
تصفح الكتاب
 العربية
العربية English
English French
French Deutsch
Deutsch Urdu
Urdu Pashto
Pashto Swahili
Swahili Hausa
Hausa