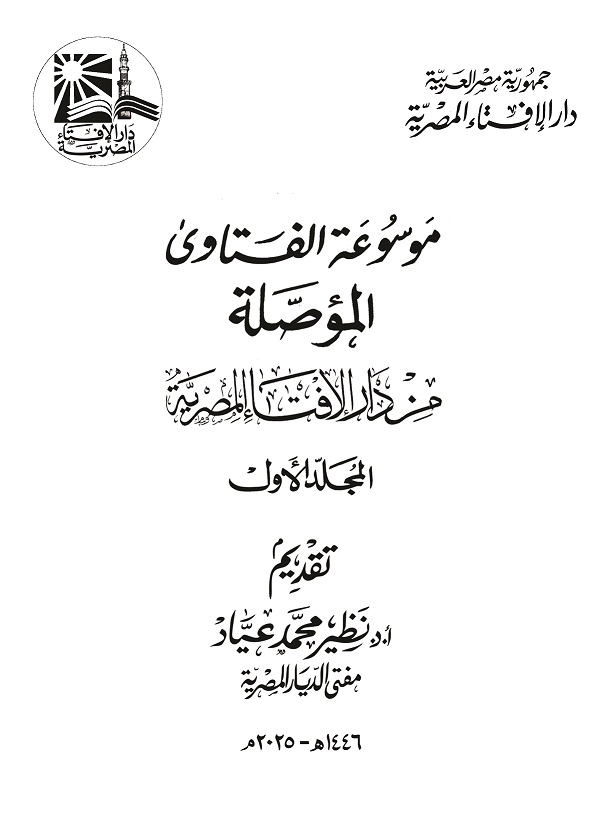بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتّقين، ولا عدوان إلّا على الظّالمين، وأصلّي وأسلّم على المبعوث رحمةً للعالمين، سيّدنا ومولانا رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه، وبعد؛
فإنّه لا علم بعد العلم بالله تعالى وبصفاته أعلى منزلةً من الفقه في الدّين؛ قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: 122]، وقال صلّى الله عليه وسلّم: «من يرد الله به خيرًا يفقّهه في الدّين»([1]).
فهو العلم الذي يمثّل الفهم الدّقيق لأحكام الشّريعة، والوقوف على مراد الشّارع الحكيم، كما أنّه يسهم – في الوقت ذاته – في توجيه سلوك الفرد المسلم إلى ما يحقّق به الصلاح لنفسه، وبني جنسه، ووطنه، خصوصًا وأنّ أحكام الفقه الإسلاميّ ما بعدت يومًا عن واقع الناس ومعيشتهم، وما جاءت إلّا لتحقيق الخير والنّفع لهم في العاجل والآجل.
ومن هذا الواقع ما نراه اليوم من حال الفتوى، وانتشار الفتاوى المضلّلة والمنحرفة، والمجافية للمنهج الوسطيّ الصّحيح، وهو ما كان له أثر سيّئ في تفشّي الاختلاف والتنازع الفكريّ بين أفراد المجتمع الواحد، بل أدّى ذلك – في بعض الأحيان – إلى هدر المقاصد الكلّيّة للشّريعة، والتطاول عليها تحت فهم خاطئ، وتوجيه سقيم.
ولا شكّ أنّ مثل هذا الأمر يتطلّب بذل الجهد في بيان الحكم الشّرعيّ، وفق الأسس العلميّة، والقواعد الأصوليّة، التي تنتج نظرًا صحيحًا، واستنباطًا جيّدًا، وإنزالًا للحكم في موضعه، بعيدًا عن انتحال المبطلين، وتأويلات الغالين، وشطحات الضالين.
ومن هنا، فإنّ إقامة المؤسّسات العلميّة المتخصّصة في الفتوى، وتشكيل هيئات جماعيّة من أهل العلم في المسائل الكبرى، يعدّ ضرورةً ملحّةً في هذا العصر، اتّقاءً لشرّ الفوضى في إصدار الأحكام، وتوحيدًا لجهود العلماء في بيان الحكم الشرعيّ المنضبط، ومراعاةً لاختلاف البيئات وظروف المجتمعات، وتحقيقًا لمقصد الشريعة في جمع الكلمة، وإزالة الغموض، وضمان سلامة المرجعيّة المعتمدة في حياة الناس.
وأمام هذه التحدّيات، يتجلّى دور الفتوى الرشيدة في ضبط قيم المجتمع، وتهذيب سلوكه، والمحافظة على حقوقه، والتّعريف بواجباته، وما يمكن أن تسهم به من تحقيق الوحدة والتماسك بين أفراده، والإقرار بالآخر، والاعتراف بالتعدّديّة الفكريّة، واحترام الاختلاف المذهبيّ، إلى غير ذلك من جوانب إيجابيّة تعود بالنّفع على البلاد والعباد.
وليس خافيًا أنّ للفتوى أثرًا مباشرًا في صون الأمن الفكريّ والاجتماعيّ، فهي تحصّن العقول من الشّبهات، وتقوّي القلوب في وجه التيّارات الهدّامة، وتعلي من شأن الاعتدال والوسطيّة، بما تسهم به في دحر مظاهر الغلوّ والانحراف، وتساعد على استقرار المجتمعات، وتماسك نسيجها الداخليّ، وتعزيز ثقتها في مرجعيّتها الدينيّة الرشيدة.
ولأجل هذا، تأتي أهمّيّة الفتوى المؤصّلة، التي يمكن أن ترفع خلافًا، وتدفع إيهامًا، وتزيل غامضًا، وتكشف تدليسًا، وتحمي مجتمعًا، وتبني أممًا، وتكرم أفرادًا، وتقرّ اختلافًا، وتمنع شرًّا، وتحقّق خيرًا؛ وهذا كلّه مردّه إلى فتوى رشيدة أسّست على أصل محكم، وشيّدت أركانها على قاعدة متينة، فراعت الواقع، وتجاوبت معه، وفي الوقت ذاته لم تهدر ركنًا من أركان الدّين، أو تهدم أصلًا من أصول الشّريعة، أو تعطّل حكمًا من أحكامها.
وكلّ ذلك لأنّ المفتي قد أعدّ عدّته، وأحكم صنعته، وأحاط علمًا بوسائله وأدواته، فأخرج لنا هذه الفتوى المؤصّلة، التي جاءت كاشفةً لمراد الشّارع، موضّحةً لمقصده، مع مراعاتها لأحوال الناس، وطبيعة أزمانهم، وأعرافهم، وبيئاتهم.
كما أنّ الفتوى الحقّة لا تنفصل عن واقع النّاس المتجدّد؛ بل إنّها تنبع من صميمه، وتتفاعل مع متغيّراته ومستجدّاته، فلا تقف عند حدّ التكرار، أو تجترّ أقوال السّابقين اجترارًا، وإنّما تعيد النّظر في ضوء المعطيات الجديدة، والملابسات الطارئة، ضمن ضوابط الاجتهاد، وحدود الاستنباط، بما يحقّق تنزيل الأحكام الشرعيّة على الواقع تنزيلًا صحيحًا، يوافق نصوص الشّريعة ويراعي مقاصدها.
فالفتوى منصب جليل الشأن، رفيع القدر، تعرف بها أحكام الشريعة، وتتّضح معالمها، ويظهر مكنونها وأسرارها، وبها يعرف الإنسان حقّه وحقّ غيره، وبها – ومن خلالها – يصل إلى مراد ربّه، ويدرك مقصوده، ويسعى لتحقيق غايته، ويبحث عن مرضات الله ورضوانه.
ولهذا، فقد اعتنى الأصوليّون بالفتوى عنايةً فائقةً، وأولوها موفور الاهتمام والرّعاية؛ فعملوا على تعريفها، وبيان أحكامها، وأنواعها، وآدابها، وشروطها، وآثارها، ومجالها، وكيفيّة إخراجها، ومعرفة أبعادها ومقاصدها ومراميها، والوقوف على مآلاتها، ويتحقّق ذلك كلّه من خلال المفتي الرشيد، الذي تتوافر فيه من الصّفات والسّمات ما يؤهّله لإصدار الفتاوى وإخراجها بصورة دقيقة محكمة، كما أشرنا آنفًا.
وقد اشترط العلماء في المجتهد أن يكون عالمًا بجملة من العلوم والفنون، وهي: القرآن الكريم، والسّنّة النبويّة المطهّرة، عالمًا بما يشترط في الأدلّة، ووجوه دلالاتها، وكيفيّة الاقتباس منها، ومعرفة مواضع الإجماع والخلاف، ومبادئ أصول الفقه، واللغة العربيّة ودلالاتها.
قال الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى: «لا يحلّ لأحد يفتي في دين الله إلّا رجل عارف بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيّه ومدنيّه، وما أريد به، وفيما أنزل؛ ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرًا باللغة، بصيرًا بالشّعر، وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف، وقلّة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هذا هكذا، فله أن يتكلّم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا، فله أن يتكلّم في العلم ولا يفتي»([2]).
وقد ذكر الخطيب البغداديّ – في باب "ذكر شروط من يصلح للفتوى" – عددًا من الأمور، كان من أبرزها قوله: «أن يكون عالمًا بالأحكام الشرعيّة، وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها، وارتياض بفروعها، وأصول الأحكام في الشرع أربعة: أحدها: العلم بكتاب الله، على الوجه الذي تصحّ به معرفة ما تضمّنه من الأحكام: محكمها ومتشابهها، وعمومها وخصوصها، ومجملها ومفسّرها، وناسخها ومنسوخها؛ والثاني: العلم بسنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، الثابتة من أقواله وأفعاله، وطرق مجيئها في التواتر والآحاد، والصحّة والفساد، وما كان منها على سبب أو إطلاق؛ والثالث: العلم بأقوال السّلف فيما أجمعوا عليه، واختلفوا فيه، ليتّبع الإجماع، ويجتهد في الرأي مع الاختلاف؛ والرابع: العلم بالقياس الموجب، لردّ الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها، والمجمع عليها؛ حتّى يجد المفتي طريقًا إلى العلم بأحكام النوازل، وتمييز الحقّ من الباطل؛ فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه، ولا يجوز له الإخلال بشيء منه»([3]).
ومن المهمّ في هذا السّياق أن ندرك أنّ الفتوى ليست مجرّد نقل للحكم الفقهيّ أو ترداد لما قيل سلفًا، وإنّما هي جهد علميّ متّصل، يجمع بين الحفظ والفهم، ويستلزم ملكة التقدير والنظر، والتفريق بين ما يفتى به في الخاصّ والعامّ، وما يناسب الفتوى لحال المستفتي، ومآلها، وما يقتضي تأجيلها أو كتمانها، مع تعلّق هذا كلّه بفقه المآلات واعتبار المصلحة الشرعيّة المتوازنة.
وقال الإمام الجوينيّ – في صفة العالم الذي يسوغ له الفتيا في الأحكام –: «أجمعوا على أنّه لا يحلّ لكلّ من شدا شيئًا من العلم أن يفتي؛ وإنّما يحلّ له الفتيا، ويحلّ للغير قبول قوله في الفتيا، إذا استجمع أوصافًا»([4]).
كما قرّر ابن السّمعانيّ أنّ المفتي ينبغي أن يستكمل: «ثلاث شرائط: أحدها: أن يكون من أهل الاجتهاد، وأن يستكمل أوصاف العدالة في الدّين؛ حتّى يثق بنفسه في التزام حقوقه، ويوثق به في القيام بشروطه، وأن يكون ضابطًا نفسه من التّسهيل، كافًّا لها عن التّرخيص؛ حتّى يقوم بحقّ الله تعالى في إظهار دينه، ويقوم بحقّ مستفتيه»([5]).
كما اشترط العلماء في المفتي أن يكون عالمًا بمقاصد الشّريعة الإسلاميّة، مدركًا للحكم والمصالح العامّة التي راعتها الشريعة؛ حتّى يتمكّن من فهم الأحكام الشرعيّة في ضوء مقاصدها، دون التوقّف عند ظواهر النّصوص.
وقد نقل الإمام الجوينيّ عن الإمام الشافعيّ قوله في منهجيّة النّظر الاجتهاديّ: «إذا وقعت واقعة، فأحوجت المجتهد إلى طلب الحكم فيها، فينظر أوّلًا في نصوص الكتاب؛ فإن وجد مسلكًا دالًّا على الحكم، فهو المراد، وإن أعوزه، انحدر إلى نصوص الأخبار المتواترة؛ فإن وجده، وإلّا انحطّ إلى نصوص أخبار الآحاد؛ فإن عثر على مغزاه، وإلّا انعطف على ظواهر الكتاب؛ فإن وجد ظاهرًا، لم يعمل بموجبه حتّى يبحث عن المخصّصات؛ فإن لاح له مخصّص، ترك العمل بفحوى الظاهر، وإن لم يتبيّن مخصّص، طرد العمل بمقتضاه، ثمّ إن لم يجد في الكتاب ظاهرًا، نزل عنه إلى ظواهر الأخبار المتواترة مع انتفاء المخصّص، ثم إلى أخبار الآحاد، فإن عدم المطلوب في هذه الدّرجات، لم يخض في القياس بعد، ولكنّه ينظر في كلّيّات الشرع ومصالحها العامّة»([6]).
وقال الإمام الجوينيّ – أيضًا – في تأكيد أهمّيّة المقاصد في فهم الشريعة: «من لم يتفطّن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، فليس على بصيرة في وضع الشريعة»([7]).
وقد جعل الإمام الشاطبيّ ذلك شرطًا لبلوغ درجة الاجتهاد، فقال: «الاجتهاد إن تعلّق بالاستنباط من النّصوص، فلا بدّ من اشتراط العلم بالعربيّة، وإن تعلّق بالمعاني من المصالح والمفاسد، مجرّدةً عن اقتضاء النّصوص لها، أو مسلّمةً من صاحب الاجتهاد في النّصوص، فلا يلزم في ذلك العلم بالعربيّة، وإنّما يلزم العلم بمقاصد الشرع، من الشريعة جملةً وتفصيلًا خاصّةً»([8]).
وقد جعل الشاطبيّ - رحمه الله - عدم معرفة المفتي بمقاصد الشّريعة سبيلًا إلى هدم كليّاتها، فقال: «ومدار الغلط في هذا الفصل إنّما هو على حرف واحد؛ إنّما هو الجهل بمقاصد الشّرع، وعدم ضمّ أطرافه بعضها إلى بعض؛ فإنّ مأخذ الأدلّة عند الأئمّة الراسخين إنّما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصّورة الواحدة، بحسب ما ثبت من كلّيّاتها وجزئيّاتها المرتّبة عليها، وعامّها المرتّب على خاصّها، ومطلقها المحمول على مقيّدها، ومجملها المفسّر بمبيّنها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها، فإذا حصل للنّاظر من جملتها حكم من الأحكام، فذلك هو الذي نطقت به حين استـنطقت»([9]).
وكذلك اشترطوا في المفتي أن يكون ثقةً، عدلًا، أمينًا، ورعًا، مأمونًا في دينه، قالوا: «فالثّقة والأمانة في أن لا يكون متساهلًا في أمر الدّين، فلا بدّ منه؛ لأنّه إذا لم يكن كذلك، لا يستقصي النّظر في الدّلائل، ومن لا يستقصي النّظر في الدّلائل، لا يصل إلى المقصود»([10]).
فكلّ هذه الأقوال تفصح عن حقيقة واحدة، وهي أنّ المفتي متى لم يكن مؤهّلًا للفتوى، فإنّه يقع في الخطأ، ويجافي الصّواب، وتصدر عنه الفتاوى الشاذّة والغريبة، التي قد تتصادم مع النّقل والعقل، والعرف والواقع.
وما يعين المفتي على تجنّب هذا الانحراف تصوّره للمسألة المستفتى عنها تصوّرًا تامًّا، من خلال تأصيلها، وبنائها على أسس شرعيّة راسخة؛ إذ الواقع يشهد بتصدّر غير المؤهّلين للإفتاء، وما أحدثوه في حياة الناس من فوضى فكريّة، وبلبلة في المفاهيم، وحيرة في المسلك، وتخبّط في السّلوك.
وإلى جوار هؤلاء، يبرز صنف آخر؛ قد يملك من العلم أدواته، ومن المعرفة وسائلها ومصادرها، إلّا أنّه يسعى إلى تحقيق منفعة شخصيّة، أو هوًى متّبع، أو ينصّب من نفسه معلّمًا لغيره دون أهليّة، أو يسيء ترتيب مقدّماته ليصل إلى نتائج يريدها، وآثار يسعى خلفها، وغايات يخطّط لها، ممّا ينتج عنه التدليس والتلبيس على الناس، والتزييف في الدّين، والتطاول على الشريعة، والخروج عليها تحت مصطلحات زائفة، ومسمّيات غريبة، أدّت إلى التناحر، والاتهام، والقدح، والذمّ، والتشكيك في الأصول والثوابت، والاعتراض عليها، وهو ما لا يستقيم مع مراد الشارع الحكيم، ولا مع دعوة الشّريعة إلى النّظر والاجتهاد والتجديد.
وهنا يقول ابن رشد في بيان ضرورة النّظر الصحيح: «إنّ النّظر في كتب القدماء واجب بالشّرع؛ إذ كان مغزاهم في كتبهم ومقصدهم، هو المقصد الذي حثّنا الشّرع عليه، وأنّ من نهى عن النّظر فيها ممّن كان أهلًا للنّظر فيها - وهو الذي جمع أمرين: أحدهما ذكاء الفطرة، والثاني العدالة الشرعيّة والفضيلة الخلقيّة - فقد صدّ الناس عن الباب الذي دعا الشّرع منه الناس إلى معرفة الله، وهو باب النّظر، المؤدّي إلى معرفته حقّ المعرفة، وذلك غاية الجهل والبعد عن الله تعالى.
وليس يلزم من أنّه إن غوى غاو بالنّظر فيها، وزلّ زال، إمّا من قبل نقص فطرته، وإمّا من قبل سوء ترتيب نظره فيها، أو من قبل غلبة شهواته عليه، أو أنّه لم يجد معلّمًا يرشده إلى فهم ما فيها، أو من قبل اجتماع هذه الأسباب فيه، أو أكثر من واحد منها، أن نمنعها عن الذي هو أهل للنّظر فيها، فإنّ هذا النّحو من الضّرر الدّاخل من قبلها هو شيء لحقها بالعرض لا بالذّات، وليس يجب فيما كان نافعًا بطبعه وذاته أن يترك، لمكان مضرّة موجودة فيه بالعرض.
ولذلك قال عليه السّلام للّذي أمره بسقي العسل أخاه لإسهال كان به، فتزايد الإسهال به لمّا سقاه العسل، وشكا ذلك إليه: "صدق الله وكذب بطن أخيك".
بل نقول: إنّ مثل من منع النّظر في كتب الحكمة من هو أهل لها، من أجل أنّ قومًا من أراذل الناس قد يظنّ بهم أنّهم ضلّوا من قبل نظرهم فيها، مثل من منع العطشان شرب الماء البارد العذب حتّى مات من العطش، لأنّ قومًا شرقوا به فماتوا، فإنّ الموت عن الماء بالشّرق أمر عارض، وعن العطش أمر ذاتيّ وضروريّ.
وهذا الذي عرض لهذه الصّنعة هو شيء عارض لسائر الصّنائع، فكم من فقيه كان الفقه سببًا لقلّة تورّعه، وخوضه في الدّنيا، بل أكثر الفقهاء كذلك نجدهم، وصناعتهم إنّما تقتضي بالذّات الفضيلة العمليّة، فإذًا لا يبعد أن يعرض في الصّناعة التي تقتضي الفضيلة العلميّة ما عرض في الصّناعة التي تقتضي الفضيلة العمليّة.
وإذا تقرّر هذا كلّه، وكنّا نعتقد – معشر المسلمين – أنّ شريعتنا هذه الإلهيّة حقّ، وأنّها هي التي نبّهت على هذه السّعادة، ودعت إليها، التي هي المعرفة بالله عزّ وجلّ وبمخلوقاته، فإنّ ذلك متقرّر عند كلّ مسلم، من الطريق الذي اقتضته جبلّته وطبيعته من التّصديق.
وذلك أنّ طباع الناس متفاضلة في التّصديق: فمنهم من يصدّق بالبرهان، ومنهم من يصدّق بالأقاويل الجدليّة تصديق صاحب البرهان بالبرهان، إذ ليس في طبيعته أكثر من ذلك، ومنهم من يصدّق بالأقاويل الخطابيّة كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانيّة.
وذلك أنّه لمّا كانت شريعتنا هذه الإلهيّة قد دعت الناس من هذه الطّرق الثّلاث إلى التّصديق بها، عمّ كلّ إنسان ذلك، إلّا من جحدها مكابرًا بلسانه، أو لم تتقرّر عنده طرق الدّعوة فيها إلى الله تعالى، لإغفاله ذلك من نفسه؛ ولذلك خصّ – عليه السّلام – بالبعث إلى الأحمر والأسود، أعني: لتضمّن شريعته طرق الدّعوة إلى الله تعالى، وذلك صريح في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125].
وإذا كانت هذه الشّريعة حقًّا، وداعيةً إلى النّظر المؤدّي إلى معرفة الحقّ، فإنّا – معشر المسلمين – نعلم على القطع أنّه لا يؤدّي النّظر البرهانيّ إلى مخالفة ما ورد به الشّرع، فإنّ الحقّ لا يضادّ الحقّ، بل يوافقه ويشهد له»([11]).
ولقد قصدت نقل النّصّ بتمامه – مع طوله – لكونه يكشف واقعًا نحياه، ويصوّر عالمًا نعيش فيه، ويشخّص داءً نتلمّسه، ويطرق أوجاعًا نعاني منها، وفي الوقت ذاته يشير إلى حقائق لا يمكن إنكارها، فالحقّ لا يعارض الحقّ، ولا يرفضه أو ينقضه.
إنّنا أمام هذه الأمور ندرك قيمة الفتوى المنضبطة، التي يتحقّق لها الانضباط، ويتوافر فيها من خلال التّأصيل العلميّ، الذي يتيح للمفتي الوقوف على المسألة بصورة صحيحة؛ يقول أبو العباس القرافي: «وأنت تعلم أنّ الفقه – وإن جلّ – إذا كان مفترقًا، تبدّدت حكمته، وقلّت طلاوته، وبعدت عند النفوس طلبته، وإذا رتّبت الأحكام مخرجةً على قواعد الشّرع، مبنيّةً على مآخذها، نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها، وأعجبت غاية الإعجاب بتقمّص لباسها»([12])، وقال أيضًا: «كلّ فقه لم يخرج على القواعد، فليس بشيء»([13]).
وحرصًا من دار الإفتاء المصريّة على نشر صناعة الفتوى الصحيحة، فقد عملت على إعداد المفتين إعدادًا جيّدًا، قيامًا بواجب الفتوى، وأداءً لأمانة المسؤوليّة، بما يحقّق الاستقرار، ويحافظ على مقاصد الشّارع، ويراعي الواقع ومتطلّباته ومآلاته.
وقد قامت دار الإفتاء بذلك من خلال إعداد فريق علميّ متخصّص، قام باستقراء الواقع، وحصر أهمّ قضاياه، وأبرز مشكلاته التي تشغل الأذهان، والتي أفرزت جملةً من الاختلافات، فعمدت إلى الإجابة عنها بصورة منهجيّة دقيقة، وذلك بالتأصيل العلميّ لها، وبيان العلاقة بينها وبين العلوم الإسلاميّة والكونيّة والتجريبيّة، ثمّ العمل بعد ذلك على تصنيفها وترتيبها حسب موضوعاتها.
فجاءت هذه القضايا والمسائل متنوّعةً؛ ما بين مسائل تتعلّق بالعقيدة بفروعها المختلفة، والشريعة بأبوابها المتعدّدة، فضلًا عن المستجدّات والنوازل الفقهيّة، والمسائل الحديثة المتنوّعة التي لها ارتباط وثيق بالشريعة ومقاصدها، كما توقّف هذا العمل العلميّ أمام جملة من العلوم والفنون التي حاول البعض التقليل من شأنها، أو ذمّها، أو ذمّ المنتسبين إليها والمشتغلين بها، إلى غير ذلك من المسائل العديدة، والقضايا الكبرى، التي تمّ عرضها في هذا السّفر العلميّ الرصين.
فأسأل الله - تعالى - للجميع التوفيق والسّداد، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه، كما أسأله - سبحانه - أن ينفع بهذا المؤلّف العباد والبلاد؛ إنّه نعم المولى ونعم النّصير.
ونظرًا لأهمّيّة هذا العمل، فقد حرصت دار الإفتاء على إعادة طبعه مرّةً أخرى؛ استجابةً لمقتضيات الواقع، وأداءً للأمانة، وإقرارًا بعظم المسؤوليّة، فإن وفّقنا، فذلك من فضل الله - عزّ وجلّ - علينا: ﴿وكان فضل اللّه عليك عظيمًا﴾، وإن كانت الأخرى، فمنّا ومن الشيطان.
والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السّبيل، وصلّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا ومولانا رسول الله ﷺ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
أ.د/ نظير محمد عياد
مفتي جمهورية مصر العربية
ورئيس الأمانة العامة لهيئة ودور الإفتاء في العالم
([1]) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، 1/25، رقم: (71)، صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب: النهي عن المسألة، 2/718، رقم: (1038).
([2]) ينظر: الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، 2/331، دار ابن الجوزي – السعوديّة، ط:2، 1421هـ.
([3]) ينظر: الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، 2/330، 331.
([4]) ينظر: التلخيص في أصول الفقه، إمام الحرمين الجويني، تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، 3/457، دار البشائر الإسلامية – بيروت.
([5]) ينظر: قواطع الأدلة في الأصول، ابن السمعاني، تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، 2/353، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: 1، 1418هـ/1999م.
([6]) ينظر: البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، 2/874، 875، دار الوفاء - المنصورة – مصر، ط: 4، 1418هـ.
([7]) ينظر: البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين، 1/206.
([8]) ينظر: الموافقات، الإمام الشاطبي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، 5/124، دار ابن عفان، ط:1، 1417هـ/ 1997م.
([9]) ينظر: الاعتصام، الإمام الشاطبي، تحقيق ودراسة: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير، د سعد بن عبد الله آل حميد، د هشام بن إسماعيل الصيني، 2/62، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط:1، 1429 هـ - 2008 م.
([10]) ينظر: قواطع الأدلة في الأصول، ابن السمعاني، 2/307.
([11]) ينظر: فصل المقال، ابن رشد، دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة، 28: 32، دار المعارف، ط:2.
([12]) ينظر: الذخيرة، الإمام القرافي، تحقيق: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، 1/36، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط:1، 1994 م.
([13]) ينظر: الذخيرة، الإمام القرافي، 1/55.
تصفح الكتاب
 العربية
العربية English
English French
French Deutsch
Deutsch Urdu
Urdu Pashto
Pashto Swahili
Swahili Hausa
Hausa