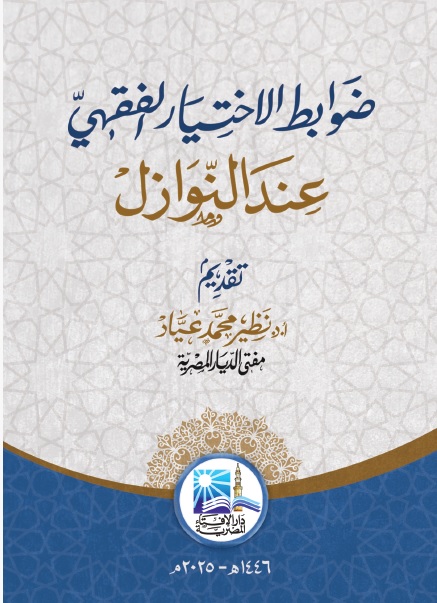الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنا ومولانا رسولِ اللهِ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّم، أمَّا بعدُ:
فمِنَ المُسلَّماتِ البدهيَّةِ في الفكرِ الإسلاميِّ -قديمًا وحديثًا- سَعةُ الفقهِ الإسلاميِّ ومرونتُهُ، بما يجعلهُ قادرًا على التكيُّفِ والتعاطي المُتزِنِ والمُتجدِّدِ مع الأحداثِ والنَّوازِلِ، برغمِ اختلافِ أحوالِها، وأماكنِها، وأزمانِها، الأمرُ الذي جعلهُ أيضًا قادرًا على بناءِ المجتمعِ الإنسانيِّ، والنُّهوضِ بهِ في جميعِ المناحي الحضاريَّةِ والاجتماعيَّةِ، بما يستوعبُ واقعَهُ، والتغيُّراتِ التي قد تطرأُ عليهِ، لصونِهِ من المخاطرِ المُحدِقةِ، وحفظِهِ من المُهدِّداتِ المُهلِكةِ.
ولا شكَّ في أنَّ الفقهَ الإسلاميَّ قد استمدَّ هذهِ الخصيصةَ من الإسلامِ ذاتهِ، وتشريعاتِهِ التي تتَّسمُ بالثابتِ والمُتغيِّرِ، والتي اعتبرَها الفقهاءُ منهاجًا رشيدًا ومتميِّزًا نحوَ تجديدِ الفقهِ الإسلاميِّ وتطويرِهِ، بما يتوافقُ مع أصولِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ، ويُراعي ضروراتِ الواقعِ وتغيُّراتِهِ، ويُحقِّق مصالحَ المجتمعِ العاجلةَ والآجلةَ.
وإذا رحنا نُعدِّدُ القواعدَ التي زخرت بها المُدوَّناتُ الأصوليَّةُ والفقهيَّةُ لتحقيقِ هذا الهدفِ، فسنجدُ منها: قواعدَ التيسيرِ ورفعِ الحرجِ: كقاعدةِ: «المشقَّةُ تجلبُ التيسيرَ»، و«إذا ضاقَ الأمرُ اتَّسَعَ»، و«الضَّروراتُ تُبيحُ المحظوراتِ»، و«الحاجةُ تُنزَّلُ منزلةَ الضَّرورةِ»، و«الأصلُ في المُعاملاتِ الإباحةُ»، وقواعدَ رفعِ الضَّررِ: كقاعدةِ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ»، و«الضَّررُ يُزالُ»، و«يُرتَكبُ أخفُّ الضَّررَينِ»، و«الضَّررُ لا يُزالُ بالضَّررِ»، وقواعدَ المصالحِ والمفاسدِ: كقاعدةِ: «دَرءُ المفاسدِ أولى مِن جَلبِ المصالحِ»، و«إذا تعارَضَتْ مفسدتانِ رُوعي أخفُّهُما ضَررًا بارتكابِ أخفِّهِما»، و«دَرءُ المفاسدِ مشروطٌ بأنْ لا يُؤدِّي إلى مثلِها»، وضرورة مراعاةِ «فقهِ الموازناتِ بينَ المصالحِ والمفاسدِ»، و«فقهِ الأولويَّاتِ»، و«اعتبارُ مآلاتِ الأفعالِ»، و«سَدُّ الذَّرائعِ»، و«فَتحُ الذَّرائعِ»، وغيرها.
وإنَّا مهما أَشبعنا الكلامَ على هذهِ القواعدِ وأهميَّتِها، فلن نُوفِّيَها حقَّها في هذا المقامِ.
ولكني أقول: يُعَدُّ الاختيار الفقهي أحد الأبعاد الدالة على فاعلية الاجتهاد في العملية الفقهية؛ إذ يتمثَّل جوهرُه في ترجيح الفقيه قولًا من بين أقوال الأئمة أو المذاهب أو السلف استنادًا إلى ما يترجح لديه من الأدلة، لا بمجرد الانتماء المذهبي، ومن ثم فإن هذا اللون من الاختيار يُعدُّ اجتهادًا مستقلًّا قد يُفضي إلى موافقة مذهب الإمام الذي ينتسب إليه المجتهد، وقد ينتهي إلى مخالفته.
وتتجلَّى هذه المخالفة في عدَّة صور، منها: اختيارُ قولِ إمامٍ آخرَ، أو تقديمُ قولٍ مخرَّج داخلَ المذهب على القولِ المنصوص، أو ترجيحُ قولٍ قد عدَّه الإمامُ مرجوحًا ضمنَ أقوالِ المسألة، ومع ذلك فإنَّ مطابقة المجتهد مذهبه لا تنفي وصف اختياره بالاجتهاد؛ إذ إن تلك الموافقةَ ناتجةٌ عن نظرٍ واستدلالٍ، لا عن تقليدٍ أو اتباع مجرد، وهو ما يجعلُ الاختيارَ الفقهيَّ ممارسةً اجتهاديةً قائمةً على أُسس علمية.
فالاختيار الفقهي لون من ألوان الاجتهاد، ولا يحسنه إلَّا من كان راسخًا في الفقه، دقيقًا في النظر، جيدًا في الاستنباط، يجمعُ بين ذكاء الفطرة والموضوعية والعدالة في التعامل مع الأقوال والأدلَّة والآراء، ومن ثَمَّ فلا يجوزُ أن يقومَ به مقلد لا دليل يؤيده ولا برهان يسانده، ولا حجة معه، ولا يستطيع أن يميزَ بين صحيحِ الأدلة من ضعيفِها، والثابت منها وغير الثابت، وما يصلح منها وما لا يصلح.
فلا يحلُّ للفقيه أو المفتي أن يتخيَّرَ بعضَ الأقوالِ اعتمادًا على الهوى وتأسيسًا على الغرض من غير اجتهاد أو نظر، وأن لا تكون الفتوى حسب الوجهات والعلاقات أو المصالح والاتجاهات وغير ذلك من الأغراض؛ لأنَّ كلَّ ذلك بعيدٌ عن الحق غريبٌ عن الصواب.
ومن ضمن هذه المنظومة أيضًا أنه: «لا رأى مقبولًا إلا بدليل صحيح أو مقبول»، «والعلماء مهما بلغوا من العلم فأقوالهم ليست أدلة، وإنما تحتاج إلى الأدلة» فالآراء وفق هذه المنظومة المنهجية المنضبطة لا تُقيَّم بقائليها، ولا حتى بدرجتهم العلمية، وإنما تقيم ويختار من بينها وفق أدلتها قوةً وضعفًا، ومن لا دليل له ساقط رأيه أصلًا.
يقول العلامة ابن حزم V في تفسير قوله تعالى: {لَا يُسَۡٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسَۡٔلُونَ} [الأنبياء: 23]: «بيان جلي أنه لا يجوزُ لأحدٍ منا أن يقولَ قولًا لا يسأل عنه، ولزمنا فرضًا سؤالُ كلِّ قائلٍ: من أين قلت كذا؟ فإن بيَّن لنا أن قوله ذلك حكاية صحيحة من ربه تعالى وعن نبيه H، لزمنا طاعته، وحَرُمَ علينا التمادي في سؤالِه، وإن لم يأتِ به مصححًا عن ربه تعالى ولا عن نبيه H ضُرب برأيه عُرض الحائط، ورُدَّ عليه أمرُه متروكًا غيرَ مقبولٍ منه، ولا مَرْضِيٍّ عنه»[1]. ومن هذا الباب ما يروى عن الإمام الشافعي I أنه قال: «إذا صحَّ الحديثُ فهو مذهبي» أو «فاضربوا بمذهبي عُرض الحائط»[2].
فالاختيار الفقهي ينبغي ألا يُقدِم عليه الفقيه إلا إذا كان جامعًا لأدواته، عالمًا بأسسه وقواعده التي تقوده إلى الاختيار الفقهي الصحيح بعيدًا عن الاختيارات الفوضوية التي لا تقوم على أساس ولا تستند على برهان؛ لأنَّ الاختيارَ الفقهيَّ تنزل الأحكام فيه على كل مكلَّف بما يليقُ به، ويتحقق معه مقصودُ الشريعة في ذلك الحكم، وهذا يتطلَّب من الفقيه المفتي أن يراعيَ أمورًا عدة منها: مراعاة الواقع، ومراعاة الحال، والزمان، والمكان، والأشخاص، ومآلات الأفعال، وعواقب التصرفات، وسد الذرائع، والموازنة بين المصالح والمفاسد، ويجمع ذلك كله أن يأتي الاختيار بما يحقق مصالح الخلق في ضوء مقصود الشرع، لا مقصود النفوس، فإنَّ مقاصدَ النفوس المجردة داعيها الهوى في الغالب، وهذا يناقض فائدة وضع الشريعة جملةً وتفصيلًا[3]؛ فإن فائدة وضع الشريعة كما يقول الإمام الشاطبي: «وتخييره بين القولين نقض لذلك الأصل، وهو غير جائز؛ فإنَّ الشريعة قد ثبت أنها تشتملُ على مصلحة جزئية في كل مسألة، وعلى مصلحة كلية في الجملة، أما الجزئية: فما يعرب عنها دليل كل حكم وحكمته، وأما الكلية: فهي أن يكون المكلف داخلًا تحت قانون معين من تكاليفِ الشرع في جميع تصرفاته: اعتقادًا، وقولًا، وعملًا، فلا يكون متبعًا لهواه كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع، ومتى خيرنا المقلدين في مذاهبِ الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبقَ لهم مرجعٌ إلا اتباع الشهوات في الاختيار، وهذا مناقضٌ لمقصدِ وضْعِ الشريعة؛ فلا يصحُّ القولُ بالتخيير على حال»[4].
وتفريعًا على هذا الأصل شدَّد العلماء على حرمة تتبُّع المفتي لرُخَص الفقهاء في الأقوال الفقهية؛ لأنه ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى، فهذا مضادٌّ لذلك الأصل المتفق عليه[5].
جاء في المجموع: «لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رُخَص المذاهب متبعًا هواه، ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف»[6].
ولهذا فإن الاختيار الفقهي ينبغي أن يقوم على عدة أمور، منها:
1- إدراك الواقع وعوالمه الأربعة.
2- مراعاة الخلاف الفقهي والنظر إلى المآلات.
وغير ذلك من أمورٍ وضوابطَ ينبغي الأخذُ بها ومراعاتُها والالتزامُ بها عند الاختيار الفقهي؛ نظرًا لأهميته وما يترتب عليه من نتائجَ، وما يُحدثه من آثار، ولهذا انتهى العلماء إلى أنَّ الاختيار الفقهي -حتى يكون صحيحًا- لا بد من قيامه على أسس ثلاثة:
أولًا: فهم النص: بأن لا يخالف دليلًا من الأدلة الشرعية المعتبرة، بل يكون قائمًا على دليل معتبر من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو غيرها من الأصول الفقهية.
ثانيًا: فقه المصلحة: بأن يكون الاختيار قائمًا على تحقيق مقاصدِ الشريعة، وهي تشييدُ المصالح العامَّة للأُمَّة، وإقامةُ العدل والمساواة، ومراعاةُ العرف الصحيح، وتيسيرُ حياة الناس، ورفْعُ الحرج عنهم.
ثالثًا: فقه الواقع: بأن يكون القائم على الاختيار الفقهي مدركًا الواقع الذي يعيش فيه؛ إذ تُعدُّ الفتوى من الأحكام الشرعية التي تخضع -في بعض صورها- لمبدأ التغير تبعًا لاختلاف جهاتها الأربع، وهي: الزمان، والمكان، والأحوال، والأشخاص.
إذ إن تغيُّر هذه الجهات الأربع يُفضي غالبًا إلى تغيُّر الفتوى بما يتلاءم مع المستجدَّات والواقع المعيش؛ فالحكم الذي يناسب بيئةً معينةً أو ظرفًا معينًا قد لا يكون مناسبًا في غيره، مما يستدعي مراعاة الخصوصيات عند إصدار الفتوى. وهذا يقع في دائرة الأحكام الاجتهادية النسبية، وهي تلك التي بُنيت على اجتهاد فقهي مستندٍ إلى أدلةٍ ظنية: كـالقياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، ونحوها من الأدلة التي تفتح المجال للنظر والاجتهاد. فهذه الأحكام بطبيعتها مرنةٌ، وقابلة للتكيُّف مع تغيُّر الواقع، وفي نطاق الأحكام الاجتهادية المستنبطة من أدلة ظنية كأدلة القياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، وغيرها من الأدلة الفرعية.
أما الأحكام القطعية الثابتة بنصوص الوحي فإنها لا تخضعُ لمبدأ التغيُّر، بل تبقى ثابتةً عبر الأزمنةِ والأمكنةِ واختلاف الأشخاص والأحوال.
ومن أمثلة الأحكام الثابتة: وجوب الصلاة، والصيام، والزكاة، وفرضية الأمانة، وحرمة الكذب، والزنا، وشرب الخمر، وإباحة البيع والشراء. فهذه أحكامٌ شرعية نصية قطعية، لا تتغيَّر؛ فلا تقبل التبديل أو التعليق على ظروف الواقع.
ونظرًا لأهمية هذا الموضوع فقد اعتنت به دار الإفتاء المصرية من خلال إدارة الأبحاث الشرعية بإعدادِ عملٍ علميٍّ محكمٍ دقيقٍ تحت عنوان «ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل».
فالكتابُ الذي بين أيدينا يتناولُ قضيَّةً مُهِمَّةً لا غِنى عنها في التَّعاطي المنهجيِّ السَّليمِ مع النَّوازِلِ والمستجدَّاتِ، وهي قضيَّةُ «الاختيارِ الفقهيِّ» الذي يُعدُّ بالأساسِ عمليَّةً فلسفيَّةً وعقليَّةً متميِّزةً، يُعمِلُ فيها الفقيهُ نَظَرَهُ بشكلٍ سديدٍ نحوَ فهمِ المسائلِ كما هي في الواقعِ، ثم يجمعُ الأدلَّةَ المتعلِّقةَ بها، ويَنظُرُ في أقوالِ الفقهاءِ القديمةِ والحديثةِ، ويُحدِّدُ مقاصدَ الشريعةِ الإسلاميَّةِ ومكارمَها، وما يُمكنُ أن يُحقِّقَ المصلحةَ ويَدفعَ المفسدةَ، ثم بعدَ ذلكَ يَختارُ القولَ المُناسبَ في مرحلةِ النَّظرِ الأخيرةِ، ويُصاغُ منهُ الحكمُ الشرعيُّ صياغةً فقهيَّةً سليمةً من أيِّ عَيبٍ أو اعتراضٍ.
إن مصطلحَ «الاختيار الفقهي» لم يكن دارجًا أو معروفًا بسياقاتِهِ المعرفيَّةِ والنظريَّةِ في التُّراثِ الإسلاميِّ، لكنَّهُ كانَ حاضرًا بشكلٍ عمليٍّ في ترجيحاتِ الفقهاءِ للمسائلِ، فقد زخرت كتاباتُهم الفقهيَّةُ والأصوليَّةُ بالأقوالِ، والأدلَّةِ، والمناقشةِ، والترجيحِ، وغيرِ ذلكَ من مراحلِ الاصطفاءِ والانتقاءِ والاختيارِ التي تهدفُ إلى التوصُّلِ إلى الحكمِ الشرعيِّ المُناسبِ في المسألةِ، سواءٌ أوافَقَ ذلكَ مذهبَ الفقيهِ أم خالفَهُ، وقد كانَ المجتهدونَ والفقهاءُ النُّظَّارُ يُراعونَ في كلِّ عصرٍ وجوهَ المصالحِ في نظرِهِم واختياراتِهِم الفقهيَّةِ، ومِن شواهدِ هذهِ المراعاةِ: العملُ بالقولِ المرجوحِ إذا احتفَّ بمدركٍ ناهضٍ، ودعت إليه مصلحةٌ راجحةٌ، والدورانُ في الاجتهادِ مع العللِ والمناطاتِ حيثُ دارت، والالتفاتُ إلى الأعرافِ الفاشيةِ في الناسِ، ومراعاةُ الظرفِ الاستثنائيِّ في التنزيلِ على الواقعاتِ. ولهذهِ الوجوهِ وغيرها أصدرَ فقهاءُ الأمَّةِ فتاوى في قضايا عصرِهم، تَنِمُّ عن سَعةِ أُفُقٍ، وجودةِ فقهٍ، ودقَّةِ نَظَرٍ مصلحيٍّ[7].
وممَّا تجدرُ الإشارةُ إليهِ في هذا السِّياقِ: أنَّ عمليَّةَ «الاختيارِ الفقهيِّ» لا تكونُ إلَّا في المسائلِ الظنيَّةِ فقط، أمَّا المسائلُ القطعيَّةُ أو التي وردَ فيها إجماعٌ فأحكامُها قطعيَّةٌ مُلزِمةٌ للفقيهِ وللمسلمِ أيًّا كان، ولا يجوزُ له الخروجُ عن هذا الحُكمِ، وإلَّا وقعَ في الضَّلالِ المُبينِ.
وإنَّ «دارَ الإفتاءِ المصريَّةَ» تستهدفُ مِن نَشرِ هذا الكتابِ الإسهامَ العلميَّ الجادَّ نحوَ تجديدِ وتطويرِ الخطابِ الفقهيِّ والإفتائيِّ المُعاصرِ، وتصحيحَ المفاهيمِ المغلوطةِ المُثارةِ حولَ الفقهِ الإسلاميِّ، والتي يُثيرُها الجُهَّالُ أو المُتربِّصونَ، ويهدفونَ مِن خلالها إلى تشويهِ صورتِه، واعتبارِهِ جامدًا غيرَ قادرٍ على معالجةِ النَّوازِلِ والمُستجدَّاتِ، وتَجليَةَ قيمةِ التُّراثِ الإسلاميِّ، وإبرازَ مكانتِهِ المُتجدِّدةِ عبرَ الأزمانِ، بما يَحويهِ مِن ذخائرَ معرفيَّةٍ، وكُنوزٍ ثقافيَّةٍ لا يُمكنُ الاستغناءُ عنها في حالِ التَّكييفِ المنهجيِّ للأحكامِ الشرعيَّةِ في الواقعِ المُعاصرِ.
كما تلفتُ هذهِ الدِّراسةُ أنظارَ الباحثينَ إلى ضرورةِ استفراغِ الوُسعِ نحوَ الاجتهادِ في كثيرٍ من القضايا والمُستجدَّاتِ الفقهيَّةِ، وتُحدِّدُ المنهجيَّةَ المُثلى في التَّرجيحِ والاختيارِ الفقهيِّ المُناسبِ للأحوالِ والأشخاصِ، وتُبيِّن معالمَها الارتكازيَّةَ الصَّحيحةَ مِن خلالِ ضَربِ النَّماذجِ والأمثلةِ التُّراثيَّةِ والواقعيَّةِ.
وتُؤكِّدُ هذهِ الدِّراسةُ أنَّ الفتوى في الأساسِ ليستْ إلَّا فكرةً فلسفيَّةً، واجتهادًا عقليًّا، ينظرُ في المسألةِ محلِّ الإفتاءِ نَظرةً عميقةً حتَّى يَستوعبَها، ويُحيطَ بجميعِ جوانبِها وأبعادِها، ثم بعدَ ذلكَ يستدعي النُّصوصَ ذاتَ الصِّلةِ بها ليُحلِّلَها ويُفكِّرَ فيها بدقَّةٍ وعمقٍ، حتَّى يستنبطَ الحُكمَ الشَّرعيَّ المُناسبَ منها، ثم ينظرَ في واقعِ المُستفتي، ويُطابقَ بينَهُ وبينَ الحكمِ الشَّرعيِّ مطابقةً دقيقةً، ليَصوغَ -في نهايةِ الأمرِ- هذا الحُكمَ صياغةً دينيَّةً فلسفيَّةً دقيقةً ومُحكَمةً، يُراعي فيها مقاصدَ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، ويُبرزُ فيها الجوانبَ الإنسانيَّةَ والحضاريَّةَ، ويُحقِّقُ فيها مصلحةَ المُستفتي، بما لا يتعارضُ والمصلحةَ العامَّةَ للوطنِ والمجتمعِ.
وتُؤكِّدُ الدِّراسةُ كذلك أنَّ الاستدلالَ بالنَّصِّ الشَّرعيِّ هو الأصلُ في الإفتاءِ، ولا يُمكنُ العدولُ عنه بأيِّ حالٍ من الأحوالِ ما دامَ هو محلَّ الاستدلالِ في المسألةِ، وفي هذا يقولُ الإمامُ الشَّاطبيُّ V: «ولقدْ زلَّ -بسببِ الإعراضِ عنِ الدَّليلِ والاعتمادِ على الرِّجالِ- أقوامٌ خرجوا بسببِ ذلكَ عن جادَّةِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ، واتَّبعوا أهواءَهم بغيرِ علمٍ، فضلُّوا عن سواءِ السَّبيلِ»[8].
كما تُؤكِّدُ ضرورةَ التحقُّقِ من مراعاةِ «اعتبارِ مآلاتِ الأفعالِ» عندَ الاختيارِ الفقهيِّ؛ حيثُ إنَّ: «النَّظرَ في مآلاتِ الأفعالِ مُعتبَرٌ مقصودٌ شرعًا، كانتِ الأفعالُ موافقةً أو مُخالفةً؛ وذلكَ أنَّ المُجتهدَ لا يَحكُمُ على فعلٍ من الأفعالِ الصَّادرةِ عن المُكلَّفينَ بالإقدامِ أو الإحجامِ إلَّا بعدَ نظرِه إلى ما يؤولُ إليهِ ذلكَ الفعلُ، فقد يكونُ مشروعًا لمصلحةٍ فيه تُستجلبُ، أو لمفسدةٍ تُدرأُ، ولكنْ لهُ مآلٌ على خلافِ ما قُصِدَ فيه، وقد يكونُ غيرَ مشروعٍ لمفسدةٍ تنشأُ عنهُ أو لمصلحةٍ تندفعُ بهِ، ولكنْ لهُ مآلٌ على خلافِ ذلكَ؛ فإذا أُطلِقَ القولُ في الأوَّلِ بالمشروعيَّةِ فرُبَّما أدَّى استجلابُ المصلحةِ فيه إلى مفسدةٍ تُساوي المصلحةَ أو تزيدُ عليها، فيكونُ هذا مانعًا من إطلاقِ القولِ بالمشروعيَّةِ، وكذلكَ إذا أُطلِقَ القولُ في الثاني بعدمِ المشروعيَّةِ، رُبَّما أدَّى استدفاعُ المفسدةِ إلى مفسدةٍ تُساوي أو تزيدُ، فلا يصحُّ إطلاقُ القولِ بعدمِ المشروعيَّةِ»[9].
وتُشدِّدُ كذلك على ضرورةِ اكتمالِ التأهيلِ الفقهيِّ المُناسبِ للمفتي قبلَ تَصدُّرِهِ للفُتيا، وإجازتِهِ للنَّظرِ والاختيارِ الفقهيِّ؛ وذلكَ لأنَّهُ -كما يقولُ الإمامُ الشَّافعيُّ V-: «ليسَ لأحدٍ أبدًا أن يقولَ في شيءٍ: حلَّ أو حَرُم، إلَّا من جهةِ العلمِ، وجهةُ العلمِ: الخبرُ في الكتابِ، أو السُّنَّةِ، أو الإجماعِ، أو القياسِ»[10].
كما أنَّ من الضَّروريِّ الإحاطةَ بوقائعِ النَّازلةِ، وفَهمَ موضوعاتِها فهمًا دقيقًا؛ فمِن المُقرَّرِ في الفقهِ الإسلاميِّ أنَّ النُّصوصَ الشَّرعيَّةَ مُتناهيةٌ ومحصورةٌ، والحوادثَ والوقائعَ غيرُ مُتناهيةٍ، ومِن ثمَّ فإنَّ التَّصوُّرَ الدقيقَ للنَّازلةِ واستيعابَها يُعدُّ خُطوةً مُهمَّةً قبل إصدارِ الحكمِ أو الفتوى فيها، وهذا يستدعي من الفقيهِ التعرُّفَ على عوالمِ الواقعِ الأربعةِ، وهي: الزَّمانُ، والمكانُ، والأحوالُ، والعاداتُ أو الأعرافُ؛ فذلكَ مما يُساعِدُهُ حتمًا في صياغةِ الحُكمِ الفقهيِّ المُناسبِ لها، بما يُحقِّقُ التيسيرَ، ويَرفعُ الحرجَ والمشقَّةَ عن الناسِ.
ومِمَّا يُؤكِّدُ ما سبقَ: ما جاءَ في رسالةِ سيِّدِنا عمرَ بنِ الخطابِ I إلى أبي موسى الأشعريِّ I: «الفَهْمَ الفَهْمَ فيما يَختلِجُ في صدرِكَ مِمَّا لم يَبلُغْكَ في الكتابِ والسُّنَّةِ، اعرِفِ الأمثالَ والأشباهَ، ثم قِسِ الأمورَ عندكَ، فاعمدْ إلى أحبِّها إلى اللهِ، وأشبَهِها بالحقِّ فيما تَرى»[11].
فالاختيارُ الفقهيُّ اجتهادٌ عقليٌّ، واستنباطٌ علميٌّ، واستنتاجٌ معرفيٌّ لا يحسنه إلا من توافرت له أدواتُه وحاز معارفَه وأساليبَه؛ فالاختيار الفقهي هو في حد ذاته ضرْبٌ من ضروبِ الاجتهاد المنضبط بقواعدَ ومعاييرَ، فهو لا يأتي إلا بعد دراسةٍ وتقييمٍ لتلك الآراء المطروحة في المسألة بما يحققُ مصالحَ المكلفين في ضوء المقاصدِ العليا للشرع الحكيم، وهذا لا يكونُ إلا من عالم مؤهلٍ لذلك من فقيه أو مفتٍ.
وقد انتظمت هذه الدراسة في فصلين:
تناول الفصل الأول منها النوازل؛ حيث جاء المبحث الأول في تعريف النوازل، وبيان أهمية الاجتهاد في معرفة حكمها، وركز المبحث الثاني على الشُّبَه التي تطرأ على الفتوى مبينًا أن أسباب الاشتباه قد تكون: تعارضَ الأدلة، أو عدمَ ورودِ الدليل، أو اختلاف العلماء، أو تردُّد الفرع بين أصلين. وتناول المبحث الثالث الواقع وعوالمه الأربعة، وأهمية إدراك الواقع. أما المبحث الرابع ففيه بيان أثر تغيُّر الجهات الأربع (الزمان، والمكان، والأحوال، والعادات) على النازلة. وتطرق في المبحث الخامس للحديث عن تقليد المذاهب الأربعة والخروج عنها، مبينًا معنى التقليد وحكمه، وحكم تقليد غير المذاهب الأربعة. وركز في المبحث السادس على القياس الفقهي والتخريج. وختم الفصل بالمبحث السابع وفيه كيفية التعامل مع الخلاف من خلال بعض القواعد الممهِّدة لفقه الخلاف، والتي منها: أن يكون مأخذ الخلاف قويًّا، وأن يكون المخالفُ من العلماء المعتبرين، وأن لا يخرج القولُ المخالفُ عن مجموع الأقوال في المسألة الواحدة، مع بيان الأمور المترتبة على كون الخلاف سائغًا ومعتبَرًا.
أما الفصل الثاني: فكان بعنوان «مواجهة النازلة»؛ حيث بدأ بتمهيدٍ بيَّن فيه ضرورة العمل بالدليل، وبيان ما قد يعرض للفقيه من الحوادثِ التي تجعله يتركُ الدليل الأقوى إلى الدليل الأضعف. ثم المبحث الأول الذي تناول النظر إلى المآلات من حيث المصلحة وسد الذريعة والاحتياط والتيسير. والمبحث الثاني ركز على الترخُّص عند الابتلاء بالمتفق عليه والمختلَف فيه، وبيان عموم البلوى وخصوصها، وتقليد من أجاز عند الابتلاء. وختم بالمبحث الثالث وفيه بعض صور الخروج عن معتمد المذهب من خلال الإفتاء بالقول الضعيف، وتتبُّع رُخَص المذاهب، والتلفيق بين المذاهب، وتغيير المسلك.
ولا يفوتُني في هذا المقامِ أن أتقدَّمَ بخالصِ الشكرِ والتقديرِ لفضيلةِ الأستاذِ الدكتور/ علي جمعة (مفتي الجمهوريَّةِ الأسبقِ- عضو هيئة كبار العلماء)، للمتابعةِ والإشرافِ على هذا العملِ المباركِ في طبعته الأولى، كما أخصُّ بالشكرِ أيضًا إدارةَ الأبحاثِ الشرعيَّةِ بدارِ الإفتاءِ المصريَّةِ التي بَذلت جُهدَها، واستفرغت وُسعَها في إعدادِ هذهِ الدِّراسةِ الجادَّةِ والمتميِّزةِ، حتَّى جاءت على النحوِ اللائقِ بها شكلًا، ومنهجًا، وموضوعًا.
واللهَ أسألُ أن يجعلَ هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، كما أسألُه تعالى دوامَ التوفيقِ والسَّدادِ، اللهمَّ آمين.
أ.د/ نظير محمد عياد
مفتي جمهوريَّة مصر العربيَّة
رئيس الأمانة العامة
لدور وهيئات الإفتاء في العالم
[1] الإحكام في أصول الأحكام، الإمام ابن حزم، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، 8/103، دار الآفاق الجديدة- بيروت.
[2] شرح التنقيح، الإمام القرافي، 2/ 509.
[3] ينظر: ضوابط الاختيار الفقهي وإبطال قول: للعامي اختيار ما يشاء من الأقوال، د. محمد العزازي صـ1500، مجلة الأزهر. عدد رمضان 1442 هـ - إبريل/ مايو 2021 م.
[4] الموافقات، الإمام الشاطبي، 5/ 77، 78.
[5] الموافقات، الإمام الشاطبي، 5/ 99.
[6] المجموع شرح المهذب، الإمام النووي، 1/ 55، دار الفكر.
[7] صناعة الفتوى، د/ قطب الريسوني، (صـ 66).
[8] الاعتصام، الشاطبي (المتوفى: 790هـ)، (2/ 863).
[9] الموافقات، الشاطبي، (5/ 177 وما بعدها باختصار).
[10] الرسالة، الشافعي، (صـ 34).
[11] السنن الكبرى، البيهقي، (رقم: 20347).
تصفح الكتاب
 العربية
العربية English
English French
French Deutsch
Deutsch Urdu
Urdu Pashto
Pashto Swahili
Swahili Hausa
Hausa